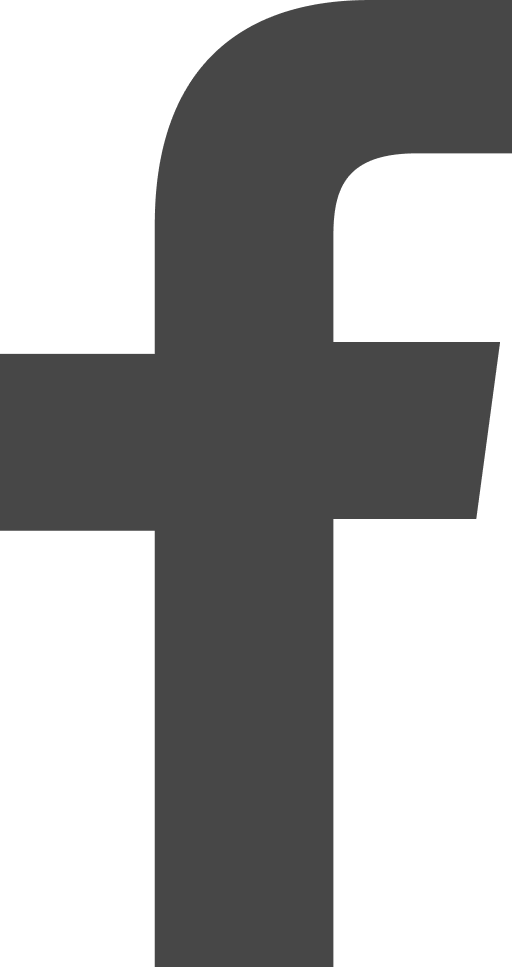تتجه بعض المؤسسات التعليمية حول العالم إلى سياسة التعلم الذاتي منذ المرحلة الابتدائية؛ بحجَّة توافر الشبكة المعلوماتية؛ وسهولة الوصول إلى الشروح المتنوعة في مختلف المجالات؛ وبما يخدم جميع المستويات؛ ولكنَّ الحقيقة التي يدركها خبراء التعليم هي أن عملية التعليم الفعَّالة ليست مجرد بحث عن المعلومات، بل تَواصل بين المعلم البشري وطلابه؛ إذ يضطلع المعلم بدور الناصح لطلابه؛ وكذلك الموجه والمربي والخبير الذي تتوسع مداركهم معه عبر النقاشات والأنشطة التفاعلية في البيئتين الصفِّيتين الابتدائية والثانوية، أو حتى في الحرم الجامعي.
ومع زيادة عدد تجارب التعلُّم الذاتي؛ يمكننا القول إن هذا التوجُّه قد أدى إلى تدهور واضح في مخرجات التعلم، خاصة في المراحل الدراسية التي تسبق التعليم الجامعي؛ ما يسلب الطلاب حقهم في الفهم الواعي والعميق لأسس الكثير من المواد العلمية مثل الرياضيات، والعلوم، وقواعد اللغات. ولم يقتصر الأمر على ذلك؛ وإنما امتد ليشمل الأثر النفسي السلبي المتمثل في قلة الثقة بالنفس، وضياع التخطيط التعليمي السليم؛ وهما أمران جاءا بسبب غياب التشجيع في حالة التعلم الذاتي؛ وكذلك بسبب عدم وجود خطة علاجية فعَّالة في حالة ضعف الطالب بموضوع ما في أثناء التعلُّم الذاتي.
ومن المؤسف أن تتبنَّى بعض المدارس حول العالم سياسة التعلم الذاتي برغم توافر المعلمين، بل تُوجِّه المعلمين إلى الجلوس في الصف الدراسي من دون تدخُّل فعَّال؛ بينما يتعلم الطلاب ذاتياً من خلال الأجهزة والتطبيقات؛ وهو ما لا يمكن قبوله إلا في حالات الدول التي لا تجد عدداً كافياً من المعلمين بالمناطق النائية. أمَّا في مراحل التعليم الجامعي؛ فيجب ألَّا يتجاوز مقدار التعلم الذاتي الثلث في كل مساق دراسي؛ وذلك كي لا يفقد الطالب فرص استقاء الخبرات الأكاديمية المباشرة من الأستاذ الجامعي؛ بحيث يكون الطالب مؤهلاً للعمل على مشروع التخرُّج بنسبة تصل إلى النصف بشكل ذاتي، على أن يتابع الأستاذ النصف الآخر بدقة؛ ويحظى بتوجيهه المفصَّل.
وفي مرحلة الدراسات العليا، التي تشمل درجتَي الماجستير والدكتوراه، تعتمد دراسة الماجستير على التعلم الذاتي بنسبة النصف في بدايتها؛ ومن ثم على التعلم الموجَّه خلال كتابة رسالة الماجستير، التي لن تكون مناسبةً لمستوى المرتبة الأكاديمية، من حيث اللغة، أو المحتوى، أو الإخراج، إن لم تكن هناك متابعة مكثفة من المشرف الأكاديمي؛ وذلك حتى يكون الطالب الباحث مهيأً ومُزوَّداً بالخبرات الضرورية التي تعينه على الانتقال إلى دراسة الدكتوراه، التي تعتمد بنسبة كبيرة على التعلم الذاتي.
وبرغم ذلك؛ فلا يمكن للباحث أن يمضي من دون متابعة جيدة وتوجيه بيِّن من المشرف الأكاديمي، يقدِّم فيه عصارة خبرته؛ ليحمي الباحث من الأخطاء المحتملة، والنواقص الشائعة؛ ويوضح له ما يجعل أطروحته لنَيل درجة الدكتوراه مرجعاً ذا قيمة يهتدي به الباحثون من بعده، ويخدم المجتمع العلمي بالشكل الأمثل.
كما يمكن للأكاديمي ذي الخبرة التمييز بسهولة بين رسائل ماجستير ودكتوراه كتبها الباحث وحده؛ أو بتوجيه محدود من المشرف، ورسائل أخرى تم إنجازها، والعمل فيها بإشراف جيد ووافر من المشرف الأكاديمي. وهنا يمكننا القول: إن التعلم الذاتي هو جزء من العملية التعليمية الفعَّالة، ويجب ألَّا يطغى على المشهد التعليمي؛ حتى لا يفقد المتعلمون حقهم في اكتساب مخرجات التعلم المناسبة، التي تمكِّنهم من المضي قدماً نحو المراحل التالية في تعليمهم، أو الارتقاء بأدائهم الوظيفي التطبيقي في مجتمعاتهم.
د. دلال مطر الشامسي *
*أستاذ مشارك في قسم علوم الأرض، مدير المركز الوطني للمياه والطاقة-جامعة الإمارات العربية المتحدة