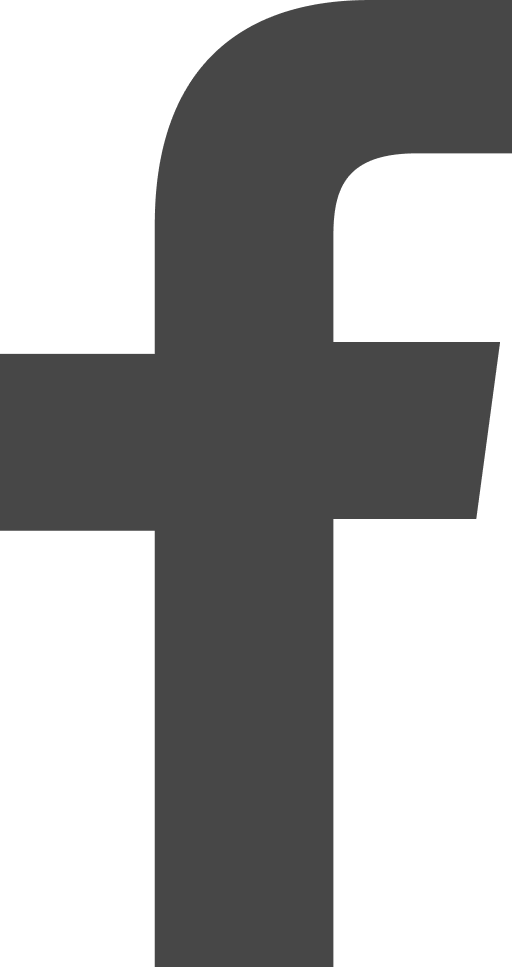في السنوات الأخيرة اتسم المشهد الاقتصادي العالمي بعودة التدابير الحمائية، وتصاعد النزاعات التجارية، وهذا التحول نحو القومية الاقتصادية، بفرض الاقتصادات الكبرى التعريفات والحواجز التجارية، يكشف عن منطقة رمادية جديدة، ليشير إلى حالة من عدم الوضوح واليقين في التجارة الدولية والنمو الاقتصادي والعلاقات الجيوسياسية، ويخلق تناقضات ومخاطر متفاوتة. الاقتصادات العربية، المعتمدة على الأسواق العالمية في صادراتها النفطية، وحركة التجارة الدولية، والاستثمارات الأجنبية، أصبحت أكثر عرضةً لتداعيات هذه التحولات في البيئة الاقتصادية العالمية.
والمعطيات تفرض على راسمي السياسات في الاقتصادات العربية المعتمِدة في الأصل على التصدير والاستثمارات فهْم الأبعاد الخفية والتأثيرات المتشابكة لهذه السياسات في الاقتصاد العالمي الحديث. الصعود العالمي للحمائية فرضت السياسات الحمائية واقعاً جديداً على الاقتصادات العربية، وبالنسبة إلى الدول المصدِّرة للنفط، مثل الدول الخليجية، شكلت هذه السياسات تهديداً مباشراً لعائداتها من الطاقة، وتسببت النزاعات التجارية بتراجع الطلب على النفط، نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي، وانعكس ذلك سلباً على موازنات الدول الخليجية التي تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، لم تتخطَّ نسبة نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 حاجز1%، وهو معدل نمو أقل كثيراً من توقعات العقد الماضي. أمَّا الاقتصادات العربية غير النفطية، مثل اقتصادات مصر والمغرب والأردن، فهي تواجه تداعيات من نوع مختلف، إذ نجد أن النزاعات التجارية والسياسات الحمائية أضرَّت بتنافسية هذه الدول، كونها تعتمد على صادرات السلع المصنعة، وتحويلات مواطنيها العاملين في الخارج، فقطاع السيارات في المغرب، مثلاً، شهد انخفاضاً بنسبة 7% في صادراته إلى الاتحاد الأوروبي عام 2023، بعد فرض الاتحاد تعريفات تفضيلية لمصلحة المنتجين المحليين. كما أن التدفقات المالية الناتجة من تراجع حجم تحويلات المغتربين تأثرت سلباً نتيجة التباطؤ الاقتصادي في الأسواق الرئيسية مثل أوروبا وأميركا الشمالية، ما أدى إلى انخفاض السيولة النقدية المتدفقة إلى هذه الدول العربية، وانعكس على القدرة الشرائية المحلية، ومستوى الاستثمارات الداخلية. تحديات التنويع في مواجهة عالم متغير برغم إدراك الدول العربية حاجة اقتصاداتها إلى تنويع قاعدة اقتصاداتها، وتوسيعها، فإن المساعي في هذا الاتجاه تواجه عقبات مختلفة في ظل البيئة العالمية الراهنة. والمبادرات الاستراتيجية الوطنية، مثل «رؤية 2030» في السعودية والاستراتيجية الصناعية في الإمارات، تُظهر تطلعات طموحة نحو التحول إلى اقتصادات مبتكرة ومتنوعة، غير أن التحولات العالمية، المتمثلة في الحواجز التجارية والحمائية، باتت تهدد بتقويض هذه الجهود، فالرسوم الجمركية، التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا على منتجات مثل الصلب والألمنيوم، أضعفت قدرة المنتجين الخليجيين على المنافسة في الأسواق العالمية، إذ تشير البيانات إلى أن دول الخليج تُصدِّر نحو 60 في المئة من إنتاجها إلى الأسواق العالمية.
وبحسب البنك الدولي، فإن التوترات التجارية قلَّلت من نمو القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 1.5 في المئة عام 2024، لتعوق بشكل واضح أجندات التنويع الاقتصادي. ومن جهة أخرى تلعب الجغرافيا دوراً مزدوجاً في التأثير في الاقتصادات العربية، إذ يوفر الموقع الاستراتيجي للدول العربية، خاصة قناة السويس التي تربط آسيا بأوروبا، فرصاً هائلة لآفاق جديدة للتجارة العربية. إلا أن التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية، وانخفاض أحجام الشحن الناجم عن تصاعد السياسات الحمائية، أثرت سلباً في إيرادات هذا الممر الحيوي، وفقدت أكثر من 60 في المئة من إيرادات القناة، ما يعادل نحو 7 مليارات دولار في عام 2024 وحده. توصيات للسياسات العربية لمواجهة تبعات الحمائية العالمية ينبغي لراسمي السياسات في المنطقة العربية إعادة تقييم الاستراتيجيات الوطنية والخارجية لضمان استمرار النمو الاقتصادي وسط هذا المناخ التجاري المضطرب، إذ يمثل التكامل الاقتصادي الإقليمي إحدى الفرص غير المستغلَّة بشكل كافٍ.
والتجارة البينية العربية، التي تمثل نحو 10-13 في المئة فقط من إجمالي التجارة بالمنطقة، لا تزال متواضعة جدّاً، ومن الممكن للاتفاقيات الإقليمية، مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكذلك يمكن للرقمنة، وتسهيل الإجراءات والأنظمة التي تحكم حركة السلع والخدمات بين الدول، أن يدعما الروابط التجارية والإنتاجية بين الدول العربية، ويسهما في تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، ويزيدا من مرونة الأنظمة الاقتصادية الوطنية.
ومن المهم التركيز على الأدوار التكاملية، وتخفيض مستويات التنافس بين الدول العربية لتقديم نموذج يرتكز على تنسيق الأدوار ليخدم النمو المشترك، وإنشاء القيمة الاقتصادية المستهدفَة. كما أن التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة يُعَدُّ خياراً استراتيجياً آخر، إذ من الأهمية بمكان أن تسعى الدول العربية إلى إعطاء الأولوية للقطاعات المستقبلية، مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والصناعات الدوائية، لتنويع محافظ صادراتها، وتُعدُّ تجربة دولة الإمارات في الاستثمار بقطاع الهيدروجين الأخضر، من أجل رفع القدرة المركَّبة للطاقة النظيفة إلى 50 في المئة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2050، نموذجاً ملهماً لدول المنطقة، فالتركيز على تطوير الصناعات التكنولوجية ذات القيمة المضافة سيتيح للدول العربية مسارات جديدة لتجاوز الحواجز التجارية التي تستهدف عادة المواد التقليدية، مثل النفط والمعادن، ومن شأنها أن تدعم قدرتها على دخول أسواق أكثر ديناميكية ومتطلبة.
وعلاوة على ذلك، ينبغي للدول العربية أن تعيد النظر في خريطتها التجارية، وأن تسعى إلى تدعيم علاقاتها التجارية مع الاقتصادات الناشئة في آسيا وأفريقيا، إذ توفر هذه المناطق فرصاً واسعة للتصدير، خاصة في قطاعات الطاقة ومواد البناء. وإجراء الشراكات الاستراتيجية مع هذه الاقتصادات قد يحدُّ من اعتماد الدول العربية على الشركاء التجاريين التقليديين في أوروبا وأميركا الشمالية، التي أصبحت تتبنَّى السياسات الحمائية بشكل متزايد، فبحسب تقرير صادر عن منظمة الإسكوا في عام 2023، فإن صادرات الدول العربية تراجعت بمقدار 11.4% مقارنة بالعام السابق. ولا بد أن تراعي الأجندات الوطنية أولوية الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية والتجارية لتدعيم القدرات التنافسية الوطنية والإقليمية.
وتُظهر مشروعات مثل توسيع قناة السويس لتطوير القدرة الاستيعابية، وتحسين كفاءة حركة الملاحة، وتحديث ميناء جبل علي للتعامل مع حجم أكبر من الحاويات والبضائع، الإمكانيات الضخمة لتحسين الكفاءة التجارية في المنطقة، ولكنَّ تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشروعات يتطلب تغيير النمط الإداري التقليدي السائد منذ عقود، والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة بحيث تتكامل مع تلك الاستثمارات الكبيرة، مثل التحول الرقمي للتجارة، وتحسين العمليات الجمركية بغيةَ تسهيل تدفق السلع والخدمات.
وعلى صعيد السياسات المالية لا يمكن الاختلاف في أهمية مبدأ تقليل الاعتماد المالي على العائدات النفطية، هذا الأمر يتطلب من راسمي السياسات تنفيذ برامج إصلاحية متعددة، خاصة فيما يتعلق بتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنويع مصادر الإيرادات الوطنية. ويجب أن يعي صانع السياسات ضرورة استقرار بيئة الاستثمار، وأهمية وصول هذه القناعة إلى القطاعين الخاصين المحلي والأجنبي، ولا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني بطبيعتها هشاشة مالية كبيرة أمام التقلبات الاقتصادية.
ويمكن أن توفر إصلاحات كهذه للحكومات العربية مزيداً من المرونة في مواجهة التقلُّبات الاقتصادية العالمية، والاضطرابات التجارية الناجمة عن الحمائية. وإحدى الركائز الأساسية الأخرى لتدعيم مرونة الاقتصادات العربية في مواجهة الحمائية الاقتصادية تكمن في ضخ المزيد من الاستثمارات لتطوير رأس المال البشري.
ولا يمكن للاقتصادات التحول نحو التنويع والنمو المستدام من دون قوة عمل مؤهلة قادرة على مواكبة المتغيرات، وتلبية متطلبات الصناعات الناشئة. ويجب أن يكون إصلاح نظم التعليم، وتدعيم برامج التدريب المهني، وتطوير مهارات الشباب في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، على رأس الأولويات الوطنية. وهذه الاستثمارات بإمكانها أن ترفع مستوى الإنتاجية، وتزيد من جاذبية المنطقة للاستثمارات الأجنبية، وتساعد في بناء اقتصادات قائمة على المعرفة والابتكار.
ومن باب التأكيد، فإن عودة الحمائية الاقتصادية، وتصاعد النزاعات التجارية، يعرِّضان المنطقة العربية لمخاطر تقلبات التجارة العالمية، واختلال الطلب على المصادر الرئيسية للاقتصادات العربية. وتتطلب هذه المعطيات سياسات استباقية ومرنة تهدف إلى بناء اقتصادات قادرة على المنافسة العالمية. والتكامل الإقليمي والتوصيات المطروحة هي دعائم محورية لبناء مستقبل اقتصادي متنوع ومتين للمنطقة، ولكنه يظل مرتهناً بمدى استعداد الفكر العربي للتخلِّي عن المفاهيم والأنماط التقليدية، والإيمان بضرورة التغيير والتحول في العقلية الاقتصادية لتضع أسساً جديدة للنمو والتطور.
*مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في جامعة الدول العربية