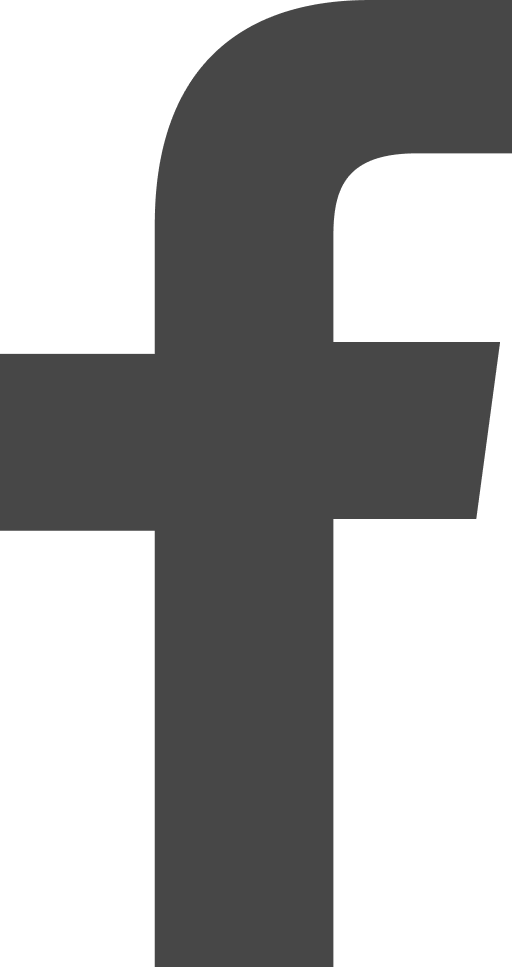شهدت ماليزيا، في السنوات الأخيرة، تفشياً متزايداً لظاهرة السمنة بين الطلاب، ما دفع الجهات المختصة إلى تبنِّي سياسات عاجلة لمكافحتها، ومن بين هذه السياسات جاء قرار مثير للجدل بربط مؤشر كتلة الجسم بدرجات الطلاب، في محاولة لإنشاء حافز يدفعهم إلى تبنِّي أنماط حياة صحية. غير أن هذا القرار، الذي جاء بصفته رد فعلٍ على أزمة صحية، يعكس إشكالية أعمق في صنع السياسات التعليمية، إذ تتحول القرارات التربوية من كونها أدوات بناء وتنمية، إلى أدوات ضغط وعقاب.
ولا شكَّ أن ارتفاع معدلات السمنة بين الطلاب يمثل تحدياً يستوجب التدخل، ولكنَّ معالجة هذه الظاهرة عبر ربط الوزن بالتحصيل الدراسي تتجاهل الأسباب الجذرية للمشكلة، فالسمنة لدى الأطفال ليست مجرد نتيجة لاختيارات فردية، بل انعكاس لعوامل متعددة تشمل النظام الغذائي، وقلة النشاط البدني، والعوامل الوراثية والاجتماعية، وبدلًا من معالجة هذه العوامل من خلال تحسين جودة الأغذية في المدارس، أو تعزيز الثقافة الصحية، لجأت ماليزيا إلى نهج عقابي يتعامل مع الأعراض من دون معالجة الأسباب الحقيقية.
وقد أدَّى ذلك إلى آثار نفسية سلبية في الطلاب، إذ زادت لديهم حالات التوتر، والقلق، واضطرابات الأكل، فضلاً عن مشاعر الإحباط لدى الذين يعانون مشكلات صحية خارجة عن إرادتهم. وغياب البعد التربوي في هذا القرار يعكس فهماً قاصراً لدور التعليم، فالأصل أن يكون التعليم أداةَ تمكينٍ، لا أداةَ ضغطٍ أو عقاب.
والإشكالية هنا ليست مقتصرة على مسألة الصحة فقط، بل تمتدُّ إلى العديد من القرارات التربوية، التي تُتخَذ بردود فعل متسرِّعة، من دون دراسة شاملة لعواملها وتأثيراتها البعيدة المدى، فكثيراً ما يكون الطالب هو الحلقة الأضعف في العملية التعليمية، ويتحمَّل تبعات مشكلات لم يكن سبباً مباشراً بحدوثها، ليصبح أول من يقع عليه العبء عند البحث عن الحلول. وحين ينخفض التحصيل الدراسي يتم اللجوء إلى تكثيف الاختبارات، وزيادة المتطلبات الأكاديمية، بدلاً من مراجعة المناهج ومدى ارتباطها بحاجات الطلاب.
وعند ملاحظة ضعف مهارات التفكير النقدي تكون الاستجابة الفورية هي إضافة مقررات جديدة بدلاً من إعادة النظر في طبيعة البيئة التعليمية، ومدى تشجيعها للبحث والاستكشاف، إذ يتم التعامل، في جميع هذه الحالات، مع الأعراض بدلاً من معالجة الأسباب، وتُفرَض حلولاً تبدو منطقية في ظاهرها، ولكنها تزيد الضغط على الطالب من دون أن تُحدِثَ تغييراً حقيقياً.
ولا ينبغي للتعليم أن يكون مجرد منظومة قائمة على الأوامر والعقوبات، بل يجب أن يتّسم بالمرونة، والتحفيز، والقدرة على التكيف مع التحولات والتحديات وفق أُسس تربوية وعلمية وإنسانية. ولا يكمُن جوهر العملية التربوية في تحميل الطالب مسؤولية الإصلاح والتغيير، بل في تأسيس بيئة تعليمية تُمكِّنه من النمو والتطور ضمن إطار يدعم قدراته، ويُراعي احتياجاته، من دون أن يكون رهينة لقرارات متسرعة وارتجالية تفتقر إلى رؤية استراتيجية شاملة.
ولا يتحقق إصلاح التعليم عبر فرض المزيد من الضغوط على الطلاب، بل من خلال تبنِّي سياسات بعيدة المدى تستند إلى البحث العميق والدراسة المستفيضة، وتأخذ في الحسبان الأبعاد النفسية، والاجتماعية، والاقتصادية، التي تؤثر في تكوين الطالب ومسيرته الأكاديمية، قبل أن يُحمَّل عبء معالجة اختلالات المنظومة التعليمية برمَّتها.
* مستشار مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.