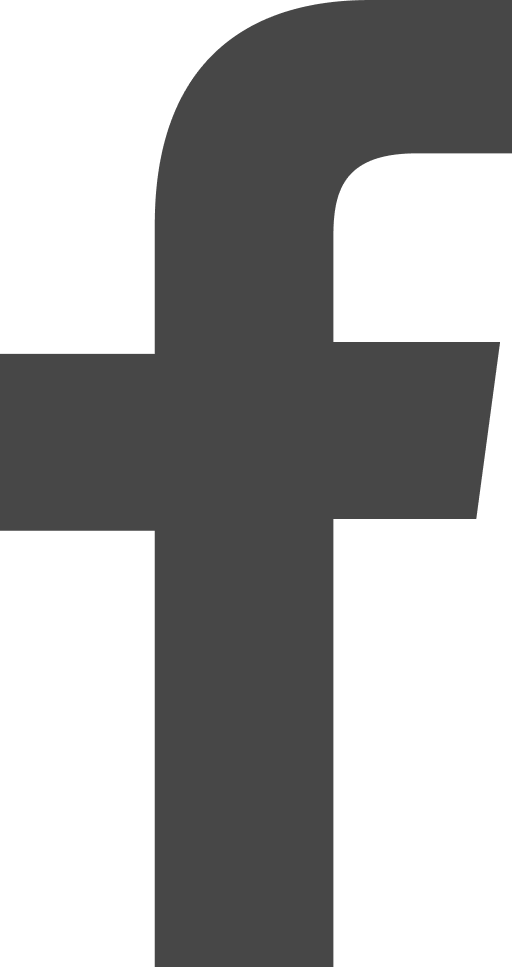كان أرسطو مهموماً بتقعيد العلوم ووضع أسسها النظرية، صنع ذلك في العلوم النظرية وفي العلوم العملية كذلك، فوضع أرسطو الأساس النظري للأخلاقيات في «نيقوماخيا»، وفي كتاب الخطابة وضع النسق النظري لصناعة «الخطابة».
يعد كتاب «الخطابة» لأرسطو من أهم النصوص في دراسة الخطابة، قديماً وحديثاً، ودراسة السّنن الاجتماعية، وهو كتاب له راهنيته، خاصة إذا علمنا أن نصوص الخطابة الحديثة والمعاصرة ليست سوى امتداد لهذا الكتاب، فقد مارس هذا الكتاب تأثيراً عميقاً على الفكر الإنساني عبر العصور. وقد أدرك الفلاسفة المسلمون أهمية هذا النص وإمكانية توظيف منافعه في السياق الدّيني والثقافي للحضارة العربية الإسلامية، فاعتنوا به كثيراً، نَظراً وشروحاً، كان من أهمها الشّرح الضخم الذي خصّه به ابن رشد.
لم يرَ فلاسفة الإسلام في كتاب «فن الخطابة» لأرسطو مجرد عمل فلسفي فقط، بل رأوا فيه دليلاً عملياً لفهم طبيعة الإنسان كائناً اجتماعياً، وكيفية التأثير الإيجابي فيه عبر اللغة. ومن هنا فتح كتاب الخطابة للفلاسفة المسلمين آفاقاً واسعة لفهم الخطاب السياسي والاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير مهارات الإقناع والتواصل التي لا غنى عنها في أي عصر. ولم يغب عنهم استخدام الخطابة في نواحٍ تشريعية ودينية أيضاً، إذ كان لهذا الكتاب المهم وقع كبير في بناء وتطوير الفكر البلاغي والفقهي الإسلامي، خاصة في مسائل الإقناع الديني والاجتماعي.
وعندما تُرجم كتاب «الخطابة» من العربية إلى اللاتينية عبر الأندلس في القرون الوسطى، شكّل نقطة انطلاق لدراسته في أوروبا، فأسهم في تطوير الخطابة السّياسية والقانونية، كما أسهم في صياغة النظريات المتعلقة بالإقناع السّياسي والخطابة القانونية، وهو ما أصبح أساساً للممارسات السياسية والقضائية في الغرب اللاتيني، كما استخدمه المفكرون لتطوير استراتيجيات في التّواصل والتفاوض، ما عزّز الخطابة كمهنة وأداة في المحاكم والقاعات السياسية، وكان تأثيره على التّعليم والفكر الأكاديمي كبيراً، إذ أصبح كتاب «الخطابة» جزءاً أساسياً من المنهاج الأكاديمي في الجامعات الأوروبية، حيث كان يُدرّس ضمن الفنون الثلاثية (trivium) التي تشمل النّحو والمنطق والبلاغة. لقد وفّر الكتاب منهجية لفهم كيفية إقناع العقول واستمالة العواطف عن طريق خطابات عقلانية- لغوية، ما ساعد في تطوير نظام تعليم مبني على التحليل النقدي.
دون أن نغفل أثر «كتاب الخطابة» في الأدب والفنون، حيث ألهم كتّاباً وشعراء في الغرب اللاتيني في تطوير نظريات البلاغة. وشكّل إطاراً لفهم التراكيب اللغوية والجمالية، ما أثر في كتابة النّصوص الأدبية والمسرحية، خاصة في عصر النهضة. واستُخدمت أفكار أرسطو حول الإقناع والعقلانية في تطوير فلسفة مسيحية تدافع عن العقيدة، خصوصاً عند توما الإكويني، كما أتاح الكتاب للفلاسفة المسيحيين أدوات عقلية لتقديم الحجج البلاغية، دفاعاً عن الإيمان، وتفسيراً للنّصوص الدينية، بل قد كان للكتاب دور كبير في التحضير لعصر النهضة، إذ كان أحد النّصوص الأساسية التي ساهمت في إحياء التّراث الكلاسيكي، خلال عصر النهضة، حيث أدى إلى تعزيز أهمية الخطابة كفنٍّ يعكس علاقة العقل بالعاطفة، وهو الأمر الذي كان له أثر في الخطاب الإنساني والنهضة الأدبية والفكرية.
إن لُحمة أي مجتمع تتوقف على فن الخطابة لإقناع أفراده بالقيم الفاضلة، وأهمية الالتزام بالسّنن المكتوبة وغير المكتوبة، والقصد من ذلك هو العمل من أجل سعادة الفرد وسعادة المجتمع، يفسر كتاب الخطابة ذلك من خلال القول في إتقان فن المشاورة، وفن حلّ النزاعات، وفن تقييم الأفعال الممدوحة والأفعال المذمومة. إنه كتاب قديم لا يزال يعلمنا كيف نبني مجتمعاً قوياً ومتماسكاً بالإقناع المنطقي، واحترام القوانين الاجتماعية.
*مدير مركز الدراسات الفلسفية بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.