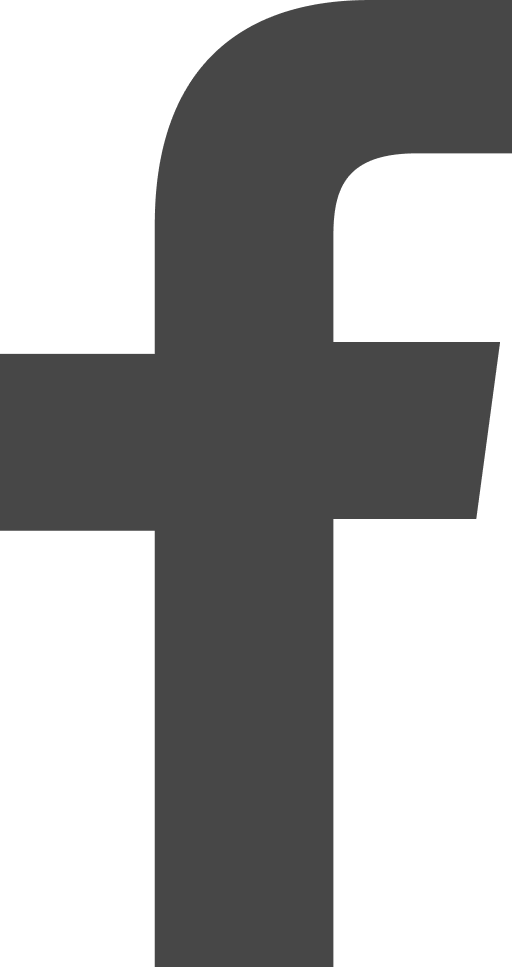كان هناك العديد من الجوانب المتعلقة بالخطط الاستراتيجية تبدو منطقية للغاية.وعلى سبيل المثال، فإن خطة الإنقاذ الأميركية بقيمة 1.9 تريليون دولار في بداية رئاسة جو بايدن، التي منعت حدوث زيادة في الفقر والبطالة مع تفشي جائحة «كوفيد-19»، كانت تبدو رهاناً صحيحاً، لا سيما بالنظر إلى ذكريات رد فعل إدارة أوباما المتردد على أزمة الإسكان في عام 2008 والركود العميق الذي تبعها.
ثم جاءت دفعة السياسة الصناعية التي تلتها (قانون الرقائق والعلوم، وقانون البنية التحتية الثنائي، وقانون الحد من التضخم) التي بدت بارعة هي كذلك، ومثّلت استراتيجية لمعالجة محنة العديد من العمال البيض الذين لا يحملون شهادة جامعية، والذين صوتوا لمصلحة دونالد ترامب في عام 2016، والذين، كما يعتقد الرأي السائد، تضرروا من تدمير وظائف المصانع.
وكان التركيز على «إعادة الإنتاج إلى الوطن» يبدو رائعاً، كما كانت الرسوم الجمركية التي فرضها بايدن على البضائع الصينية، بناءً على موقف سلفه كحامٍ للعمال الأميركيين ضد المنافسة الأجنبية غير العادلة. وقد بدا النهج المتشدد في تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار طريقة معقولة لبناء مصداقية بايدن كمدافع عن العامل البسيط. وحتى اللغة حول إعادة بناء الاقتصاد «من الأسفل إلى الأعلى ومن المنتصف إلى الخارج» كانت تحمل نغمة واعدة، تتناسب مع مشاعر الاستياء تجاه تبنّي واشنطن الطويل لسياسات «التقطير من الأعلى». وكان بايدن أول رئيس ينضم إلى صف اعتصام نقابي.
قبل الانتخابات بأسبوع فقط، أصدر البيت الأبيض تقريراً يُهنئ فيه نفسَه بنمو الاقتصاد الاستثنائي: حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 12.6% في عهد بايدن، متفوقاً على نمو الدول النظيرة. وعلاوة على ذلك، ظل معدل البطالة منخفضاً بشكل ملحوظ، نظراً للجهود الناجحة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لإعادة التضخم إلى مستوياته المنخفضة. وارتفع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار.
لكن لم يكن لذلك أي تأثير، فقد اعتبر 18% من الناخبين أن الاقتصاد يحقق تقدماً مهماً، وعلى ذلك الأساس اختاروا كامالا هاريس، وفقاً لاستطلاعات الرأي، بينما اعتبر أكثرُ من ثلثي الناخبين حالةَ الاقتصاد غير جيدة أو سيئة، واختارت 70% منهم ترامب.
وربما يمكن تفسير هذا النمط بالقول إن الأسعار أهم بكثير من الوظائف بالنسبة للناخبين الأميركيين. وبغض النظر عن مدى قوة سوق العمل، حيث كان معدل البطالة يزيد قليلاً على 4% في نوفمبر، إلا أنه لم يكن بمثابة عزاء للناخبين الغاضبين من التضخم السنوي الذي بلغ ذروته بنسبة 9% في منتصف عام 2022، قبل أن يستقر عند 2.7%.
وعلاوة على ذلك، تبين أن الناخبين لا ينظرون إلى التضخم بالطريقة نفسها التي ينظر بها أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ربما يشعر أفراد الاحتياطي الفيدرالي أن الثناء مستحق بسبب سرعة احتواء التضخم دون حدوث ضرر ملحوظ في سوق العمل، لكن الناخبين، من ناحية أخرى، يهتمون بمستويات الأسعار. والأسعار الاستهلاكية أعلى بنسبة 20% مما كانت عليه عندما غادر ترامب منصبه.
هناك نظريات أخرى لشرح لماذا فشلت «بايدينوميكس» في أداء جيد في صناديق الاقتراع. ربما كان الناخبون غاضبين من «الفوضى على الحدود» لدرجة أن أي أخبار اقتصادية جيدة لم تكن لتغير رأيهم. وقد اقترح الاقتصاديون أن الاقتصادات القوية عادة ما تفضل «الجمهوريين»، لأن الناخبين يشعرون بالثراء ويكونون أكثر ميلاً لتفضيل الضرائب المنخفضة، لكن عندما يكون الاقتصاد في حالة صعوبة، يعيدون اكتشاف تقديرهم للتأمين الاجتماعي، ويتوجهون نحو «الديمقراطيين».
لكن «داني رودريك»، أستاذ الاقتصاد في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، لديه المقترح الأكثر إقناعاً: فكرة «الطبقة العاملة» في «بايدينوميكس» عفا عليها الزمن ببضعة عقود.
والواقع أن قطاع التصنيع لا يوظف سوى نحو 13 مليون عامل من بين نحو 160 مليون عامل يعملون خارج المزارع. ولا يمثل النقابات سوى أقل من 1.4 مليون منهم. وكانت السياسات الصناعية والحواجز التجارية، والخطب التي تُلقى في خطوط الاعتصام، والحديث عن عودة المصانع إلى المناطق الريفية المتخلفة، كلها تستهدف ركناً صغيراً من المجتمع الأميركي.
«إن السياسة التي تعد بإعادة الطبقة الوسطى من خلال إعادة التصنيع ليست فقط غير واقعية»، كما كتب رودريك في «مشروع سنديكيت»، وإنما «غير صادقة أيضاً، لأنها لا تتماشى مع تطلعات العمال وتجاربهم اليومية».
هناك ما يقرب من 16 مليون عامل في تجارة التجزئة، و17 مليون في قطاع الترفيه والضيافة، وحوالي 18 مليون في الرعاية الصحية. وبالتأكيد، استفادوا من بعض سياسات بايدن، لكن الحوافز في قانون الحد من التضخم للمقاولين الذين يعملون مع العمال النقابيين لم تفعل شيئاً من أجلهم.
لذا ربما لا يكون الدرس المستفاد لبعض الإدارات الديمقراطية المستقبلية التي تأمل في مساعدة الطبقة العاملة بالضرورة أن السياسات الشعبوية لا تنجح، بل إن هذه السياسات يجب أن تستهدف ما أصبحت عليه أميركا، وليس ما كانت عليه قبل عقود من الزمان.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسينج آند سينديكيشن»