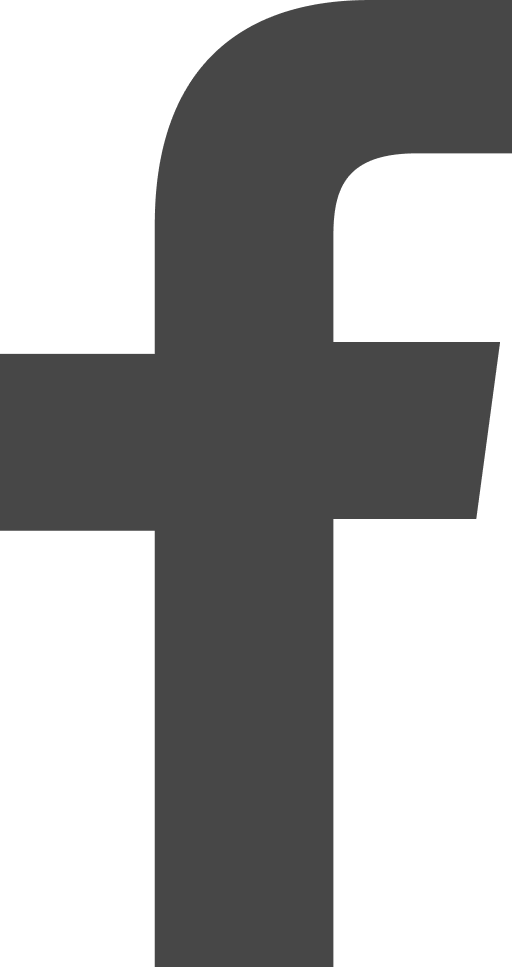بدأت فرنسا قبل 200 عام تسجيل معدل عمر المواطن الفرنسي. وفي عام 1816 كان معدّل عمر المرأة 41.1 عام، والآن أصبح 85.3 عام. وكان معدل عمر الرجل 39.1 عام، والآن أصبح 79.3 عام.
وما يصحّ على فرنسا يصحّ على دول العالم كافة: معنى ذلك أن زيادة عمر الإنسان بلغت خمس ساعات في اليوم الواحد. ومعنى ذلك أيضاً أن كل إنسان (فرنسي هنا) يقترب يومياً من الموت الحتمي 19 ساعة كل يوم، وليس 24 ساعة.
«كل من عليها فانٍ»، والموت نهاية حتمية لكل كائن حيّ، لكن التوقيت يتأخر بفعل عوامل التغذية والرعاية الصحية. كان معدل عمر الإنسان في العصور الغابرة لا يزيد على الثلاثين عاماً. وكان يلقى حتفه، إما بالوقوع من صخرة مرتفعة، أو غرقاً في بحيرة، أو فريسةً بين أنياب تمساح، أو تحت أقدام فيل في غابة.. إلخ.
وقبل عشرة آلاف سنة عرف الإنسان الزراعةَ، وانتقل من حركة الصيد إلى الإقامة الدائمة لرعاية مزروعاته والعيش عليها. وأدّت زراعة القمح والذُّرة والشعير إلى توفر حياة أكثر استقراراً واطمئناناً، فارتفع العدد من 4 ملايين إنسان في عام 10 آلاف سنة قبل الميلاد إلى 5 ملايين إنسان في عام 5 آلاف سنة قبل الميلاد. لكن الزراعة أدت إلى إنتاج أمراض جديدة نتيجة نمو الحشرات التي لم تكن موجودة من قبل، أو لم تكن معروفة قبل الزراعة، وما تزال آثارها مستمرة حتى يومنا الحالي. ذلك أن معظم الأوبئة التي تصيب الإنسان اليوم تعود إلى تلك الحيوانات الصغيرة المجهرية التي تعيش على الزراعة وتنتقل إلى الإنسان في الهواء، أو عبر الماء، أو من خلال الطعام غير المطبوخ. فمرض الحصبة على سبيل المثال يأتي من الماشية التي استطاع الإنسان تدجينها والعيش معها، واعتماداً على لحومها وألبانها وجلودها وصوفها، ومرض الإنفلونزا يأتي من الدجاج.. إلخ. ثم إن تطور الحياة الإنسانية من العيش منفرداً إلى العيش الجماعي بعد الزراعة سهّل عملية انتقال المرض من إنسان إلى آخر، وهو الانتقال الذي أدّى إلى التأثير سلباً على سلامة حياة الإنسان.
كان المرض يعد عقاباً من الله، ومرّ الإنسان بتغيرات طويلة حتى أدرك أن للمرض أسباباً قابلة للمعالجة والاحتواء.
في عام 1854 بحث طبيب إنجليزي يُدعى «جون شو» في أسباب انتشار مرض الكوليرا في مدينة لندن. يومها كان هذا المرض فتاكاً جداً يقضي على المصاب به بعد 12 ساعة فقط. واكتشف الدكتور «شو» أن جرثومة المرض تحملها المياه الآسنة والملوثة. وفي الوقت ذاته، اكتشف طبيب نمساوي (من أصل مجري) يُدعى «إيغتاس سيملوير» أن نظافة غرف التوليد في المستشفيات من شأنها أن تنقذ حياة الأطفال حديثي الولادة. وهكذا بدأت الإنسانية من القرن التاسع عشر مسيرةً جديدة بالاعتماد على النظافة لمكافحة الأمراض وقائياً.. ومن ثم للعيش لفترات أطول.
وأدّى اكتشاف التلقيح ضد الأمراض سريعة الانتشار إلى تقدّم العلاج الطبّي، ومن ثم إلى تمكين الإنسان من مقاومة المرض، وبالتالي إلى إطالة أيام حياته.
يروي المؤرخ البريطاني «سايمون شاما»، في كتابه «الأجسام الغريبة»، كيف تمكّن الدكتور «ادوارد جنيفر» في عام 1796 من تلقيح طفل ضد مرض الحصبة، وذلك للمرة الأولى في التاريخ. وفي الرواية الطبية يقول «شاما» إن الدكتور جنيفر استخرج عيّنةً من سيّدة عجوز أصيبت بالمرض، ولقّح بها الطفل «جيمس فيليب».
إن نظرية «وداوني بالتي كانت هي الداء»، لم تكن معروفة حتى ذلك الوقت. ليس بالمعنى النوّاسي، ولكن بالمعنى الطبي الحديث. ذلك أن إدخالَ كمية صغيرة من جراثيم المرض إلى جسم الإنسان تحفّز الخلايا النائمة لإطلاق قواتها لمقاومة الغزو الخارجي متمثلاً في هذه الجراثيم، وهو المبدأ الذي تقوم عليه فلسفة التلقيح الطبي. فالتلقيح ليس علاجاً في حد ذاته، ولكنه أداة لاستنفار الخلايا التي خلقها الله في جسم الإنسان لمقاومة القوى الجرثومية الغازية من خارج الجسم.
وأدّت نجاحات العلاج الطبي والتلقيح وثقافة النظافة واعتماد المعايير الصحية الخاصة والعامة إلى تمكين الإنسان من مقاومة الأمراض القاتلة، وبالتالي إلى إطالة عمره.. حتى إنه في اليابان اليوم نحو مليون شخص ممن تتجاوز أعمارهم المائة عام، لكن في الحسابات الأخيرة: «كل نفس ذائقة الموت، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام».
*كاتب لبناني