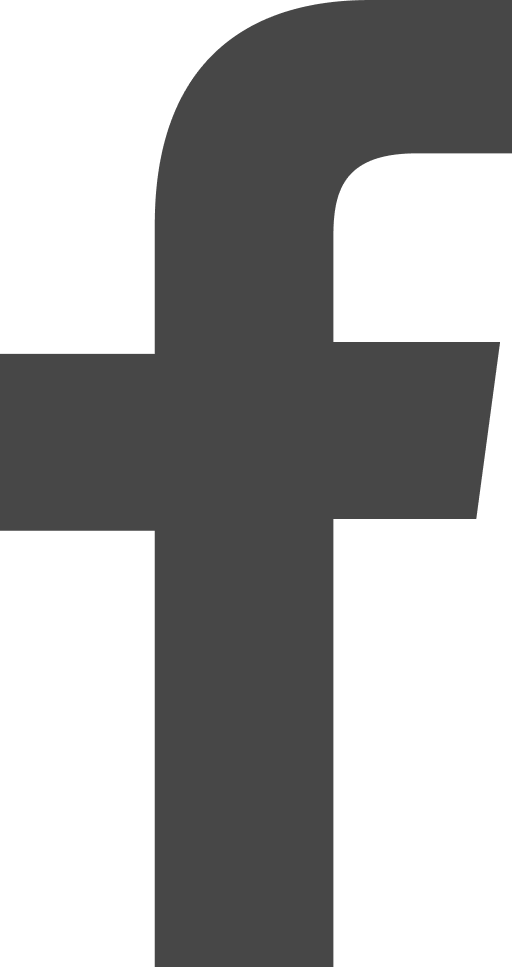مع نهايات العصور الوسطى في أوربا أخذ بعض الكتاب يطرحون في كتاباتهم السياسية مسألة رضا الشعب، بل كان منهم من وظف مفهوم "العقد" في طرح مسألة "السيادة" للشعب وتأسيس حقه في مقاومة حكم الطغيان، وكان ذلك، خاصة، خلال الصراعات الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت في عصر النهضة. يتعلق الأمر في البداية بنظرية أشهرها بعض الكتاب البروتستانت في وجه الملوك الكاثوليك، نظرية تقول بعقدين فعرفت بنظرية "العقد المزدوج": الأول بين الله والشعب، والثاني تابع للأول وهو بين الملك والشعب. وفحوى هذا العقد بشقيه أنه إذا اضطهد الملك "الدين الحقيقي" –دين أتباع الكنيسة- فهو يخرق الميثاق الذي بين الله والشعب وبالتالي يمكن لهذا الأخير استعمال حقه في المقاومة. إن ما يشرِّع له هذا العقد ليس تدخل البابا، كما رأينا في المقال السابق عند أنصار المذهب الغريغوري في القرن الثالث عشر، بل إن ما يشرِّع له الآن، في القرن السادس عشر، من خلال العقد المزدوج، هو حق الشعب نفسه في مقاومة طغيان الملك. إن نظرية العقد المزدوج أصبحت الآن تقوم بوظيفة إيديولوجية واضحة وهي الحد من سلطة الملك بالوقوف في وجه الملكية المطلقة القائمة على ما عرف بـنظرية "الحق الإلهي للملوك"، وهي نظرية تقرر أن الملوك يستمدون سلطتهم من الله وبالتالي فهم مسئولون أمامه وليس أمام الناس. ومن هنا ستكون وظيفة نظرية "العقد الاجتماعي" هي جعل الملوك مسئولين أمام الناس. وأكثر من ذلك كان لظهور الأفكار التعاقدية في جو الصراعات الدينية التي سادت أوربا دور هام في نضج مفهوم "التسامح".
ومع بدايات القرن السابع عشر تحول "العقد المزدوج" من عقد بين ثلاثة أطراف (عقد بين الله والشعب، وعقد بين الملك والشعب) إلى عقد مزدوج فعلا ولكن بين طرفين فقط: الشعب والدولة. العقد الأول يؤسس المجتمع، والثاني يؤسس الحكومة. فبموجب العقد الأول تخلى الناس عن استقلالهم، الذي يتمتعون به في الحالة الطبيعية، لصالح المجموع. وفي المقابل يحصلون على حماية حقوقهم الفردية وضمانها وفي مقدمتها حق الملكية. وبموجب العقد الثاني ينقل الشعب السيادة إلى واحد أو أكثر من القضاة magistrat ليمارسوها تحت بعض الشروط.
يبدو أن نظرية العقد المزدوج هذه كانت تشكل نوعا من المرحلة الانتقالية. ذلك أنه سرعان ما سينظر إليها على أنها تشكل عقبة، سواء من طرف أنصار الملكية المطلقة أو من طرف المنادين بـمبدأ "السيادة للشعب". وإضافة إلى ذلك تبين أن هذا العقد المزدوج تكتنفه صعوبات نظرية: فإذا كان العقد الأول، عقد الاجتماع، ينتهي أمره عند اتفاق الناس على الاجتماع والعيش معا، فلماذا لا ينتهي العقد الثاني عند اتفاقهم على تنازلهم عن حقوقهم للملك؟ إن فرض واجبات على الملك أمر يقع خارج العقد وبالتالي فسلطة الملك يجب أن لا تكون محدودة بحد!
ومع أن معظم الكتاب قد تخلوا عن فكرة العقد المزدوج التي أصبحت موضوع استغلال من طرف أنصار الملكية المطلقة فإن بعض من ناهضوا الحكم المطلق بقوا متمسكين بفكرة العقد المزدوج ولكن مع التأكيد على أنه عقد يقوم على تبادل: تنازل الناس للملك عن حقوقهم مقابل التزام هذا الأخير بواجبات معينة. فتنازل الطرف الأول عن حقوقه تترتب عنه واجبات في عنق الطرف الثاني.
من الذين أسسوا لهذا الاتجاه جان دون سكوت Jean Duns Scot (1263-1308: ولد في إيكوسيا وعاش في انجلترا وفرنسا وألمانيا). كان القديس توما الإكويني يرى رأي أرسطو كما ذكرنا في المقال السابق، فكان يقرر مثله أن الأسرة والمدينة (المجتمع) هما ظاهرتان طبيعيتان تماما، لأن الإنسان مدني بالطبع. أما جان دون سكوت فيرى أنه إذا كانت الأسرة هي، فعلا، أسبق ظهوراً وأن الزواج شيء بدائي و يقوم مع ذلك على عقد تبادل، فإن المدينة/الدولة مؤسسة متأخرة عنهما وأنها تقوم على التعاقد. ذلك أنه بما أن الحياة البشرية في هذا العالم معرضة للوقوع فريسة لقانون الغاب فمن الضروري وضع قوانين وتشريعات عادلة تقي الناس من الظلم والصراع والفوضى. ومن هنا كان من الضروري معرفة من هو أصلح وأقدر على وضع مثل هذه القوانين. ذلك أنه إذا كانت سلطة الأب قد تكفي بالنسبة للجماعات الصغيرة في بداية الأمر، فإن نمو هذه الجماعات واتساعها وتزاحمها واختلاف مصالحها، وما قد تتعرض له من تهديد خارجي الخ، كل ذلك يجعل قيام سلطة عامة شيئا ضروريا. وهذا يكون بالتعاقد.
إذا كان بعض مؤرخي الفكر السياسي في أوربا يرون أن دون سكوت ربما يكون قد أخذ فكرة العقد من عقد الولاء والخضوع الذي يربط اليهود بملوكهم الأولين كما في التوراة، فإن آخرين يرون أن في نظريته ما يتجاوز ميثاق بني إسرائيل مع ملوكهم، ولذلك فهم يربطون أفكاره بالتحالفات التي عرفتها، عام 1291، الكانتونات الثلاث الأولى في سويسرا. فالعقد الذي تصوره سكوت يقضي بأن تسلم الجماعة بموجبه إلى طرف آخر، ملكا كان أو مجلسا أو إلى المجتمع كله، سلطة وضع القوانين باسم المجموع ولفائدته. وكيفما كان الأمر فالفريقان معا يقرران أن دون سكوت ساهم مسا