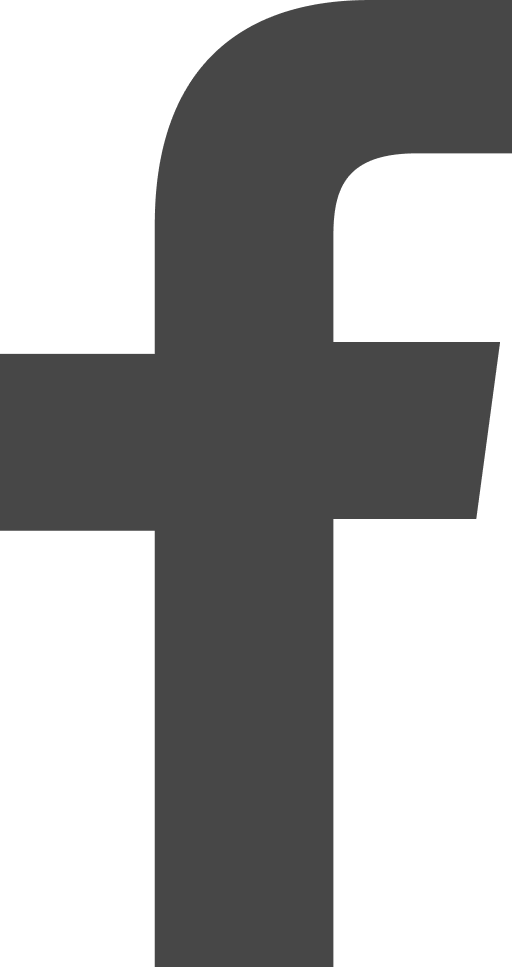في مقالة سابقة (7 مارس 2004) ذكرت أن من الخصائص التي تميز الوهابية عن سواها من الحركات الدينية السياسية التي ظهرت في التاريخ الإسلامي الحديث هو تمييزها الواضح والصارم والثابت بين وظيفة كل من رجل الدين من ناحية، ورجل السياسة أو رجل الدولة، من ناحية أخرى. منذ قيام الدولة السعودية الأولى في منتصف القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي كان هناك نوع من العقد غير المكتوب يربط بين دور كل منهما في تسيير أمور الدولة. دور رجل السياسة أو رجل الدولة يتحرك ضمن المجال السياسي للدولة، وله في ذلك كل الحرية على ألا يتعارض ذلك مع ثابت من ثوابت الشريعة. من ناحيته يتحرك رجل الدين ضمن المجال الديني للدولة، ويتمتع بحرية واسعة هنا أيضا. لكن إذا كان رجل الدولة مقيدا بالشريعة، فإن رجل الدين مقيد هو الآخر بحدود السياسة وما يرتبط بها من مصالح عامة، أو خاصة تتعلق به هو، أو بولي الأمر، إلى جانب موازين القوة وهي أحد أبرز حدود العملية السياسية، ودور كل طرف منخرط فيها.
إلى هنا والأمر يعتبر عاديا. لكن هناك إضافتين مهمتين. الأولى أن التمييز الوهابي بين الفقيه ورجل الدولة ليس إبداعا وهابيا، وإنما يعكس إيمانا عَقديا راسخا، وتطبيقا عمليا لما جاء في مدرسة الإمام أحمد بن حنبل حول هذه المسألة. ولأن الدولة السعودية، وهذا هو الأمر الثاني، قامت في أساسها على يد الحركة الوهابية، كانت ولا تزال هي الدولة الإسلامية الأولى والوحيدة في التاريخ الإسلامي التي تبنت المذهب الحنبلي. من أين يأتي التميز الوهابي في هذه الحالة؟ يأتي في تصوري من أنها كانت أول تطبيق عملي للمعادلة الحنبلية لعلاقة الديني بالسياسي، وثانيا التزامها العملي الصارم والثابت بهذه المعادلة، وعلى مدى ما يقرب من ثلاثمائة سنة حتى الآن. هذه الاستمرارية والثبات على هذه المعادلة يعكس إيمانا عقديا راسخا بهذا المبدأ الحنبلي.
ما هي معالم الالتزام والثبات المشار إليهما؟ هناك ملاحظة مهمة لم يُلتفت إليها بما تستحقه من اهتمام، وهي أنه طوال تاريخ الدولة السعودية، بكل ما اكتنفه من لحظات قوة وضعف، التزم رجال الدين الوهابيون بدورهم الديني، خاصة منهم كبار الوهابيين من بيت الشيخ محمد بن عبدالوهاب، المعروفين بـ"آل الشيخ". حيث أثبت هذا البيت ولاءه للبيت السعودي، وأنه حليف لا يخشى منه منافسة سياسية. ليس هناك أية إشارة في جميع المصادر التاريخية على أن أيا من رجال الدين الوهابيين راوده طموح سياسي خارج إطار مركزه الديني. حتى في اللحظات التي ضعفت فيها الدولة وتعرضت للسقوط، بقي الوهابيون على التزامهم القوي بأن دورهم لا يتجاوز مجال الدين، والفتوى الدينية إلى مجال السياسة، أو الإمارة السياسية.
سقطت الدولة في مرحلتها الأولى أوائل القرن التاسع عشر على يد الحملة المصرية ــ العثمانية، مما يشير إلى فشل القيادة السياسية للدولة. كان من الممكن استخدام ذلك كمبرر لطموح سياسي من قبل بعض القيادات الوهابية، باعتبارهم آنذاك كانوا شركاء للقيادة السياسية. لكن هذا لم يحصل. ربما قيل إن أغلب قيادات الدولة، الديني منها والسياسي، تم ترحيلهم إلى مصر. لكن المهم هنا أن فكرة الالتزام بعدم الخلط بين الدور الديني والسياسي بقيت حاضرة وحاكمة حتى في لحظة حرجة مثل هذه، دخلت فيها المنطقة حالة من الفوضى السياسية بسبب الاحتلال. ثم جاءت لحظة أكثر دلالة هنا من حيث أنها شهدت ضعف الدولة وتداعيها من الداخل، ومن دون تدخل خارجي. وكانت تلك هي اللحظة التي بدأت بعد وفاة رئيس الدولة السعودية في مرحلتها الثانية، أواخر النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وهو الإمام فيصل بن تركي. آنذاك انفجر صراع مسلح طويل وبطيء بين ولدي الإمام فيصل على الحكم. كان مفتي الدولة وقتها هو الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن. وكان يحظى بمكانة دينية واجتماعية بارزة. وقد لعب دورا كبيرا في محاولة رأب الصدع، لكن من دون جدوى. كان واضحا أن البيت السعودي في حالة انقسام يصعب رأبها. وقد اتضح أن الأمور كانت تتجه أمام عيني المفتي، وبقية رجال الدين، إلى سقوط الدولة. ومع ذلك لم يحدث أن أحدا من الوهابيين، وخاصة المفتي، فكر بالتدخل لتولي السلطة السياسية، على الأقل من منطلق إنقاذ الموقف. على العكس كان الوهابيون مجبرين، كما يبدو، على ترك الصراع السياسي بين ابني الإمام يأخذ مجراه الطبيعي. وهو الصراع الذي أنهك الدولة، وانتهى أخيرا بسقوطها على يد بيت لا يعدم الطموح السياسي، وهو بيت آل رشيد من منطقة حائل.
كيف يمكن تفسير مثل هذا الموقف من مؤسسة دينية تمثل ركيزة أساسية للدولة، وهي في الوقت نفسه تعتبر شريكة في الحكم؟ تبرز أهمية هذا السؤال من حقيقة أن مؤسس الحركة، الشيخ محمد بن عبدالوهاب، كان هو صاحب فكرة الدولة المركزية. وأن حركته، وإن كانت حركة دينية تجديدية، إلا أنها كانت كذلك من حيث إنها هدفت أولا إلى تأسيس الدولة، وتوحيد مناطق الجزيرة داخل هذه الدولة. وعندما قامت الدولة كان له فيها دور محوري وحيوي حيث تولى شؤون ب