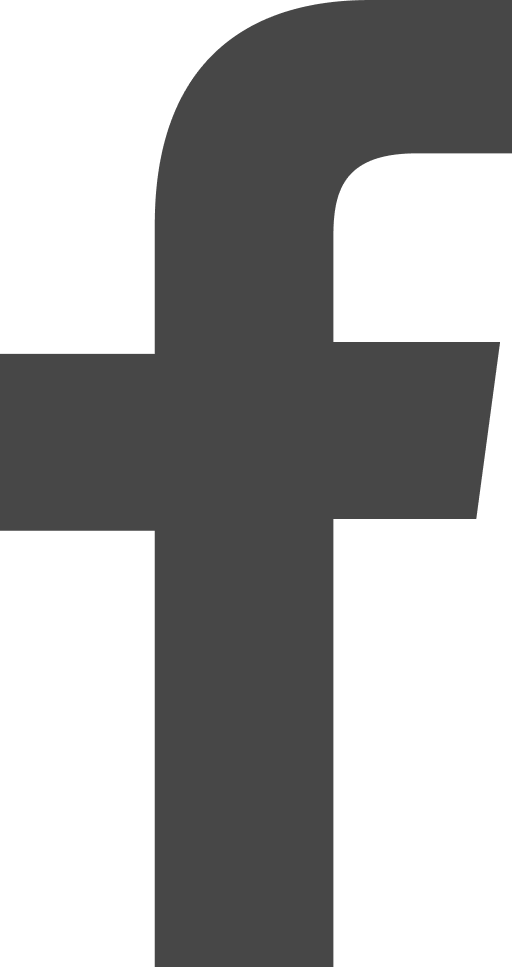إذ أكتب من فلسطين، أكتشف من جديد "كلمة السر" في الصمود الفلسطيني المغموس بالمعاناة. وسواء في المناطق المحتلة، أو خارجها في دول المهجر والشتات (حوالي 60% من الشعب الفلسطيني) فإن المعاناة هي قديمة/ جديدة، ولو متباينة. فمن يعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي ليس كمن يعيش خارجه. ومن يستضيفه هذا البلد العربي غير من يستضيفه ذلك البلد العربي، ناهيك عن البلد الأجنبي. وتوثيق المعاناة الفلسطينية في الوطن والشتات ربما يحتاج إلى ما يزيد على آلاف الصفحات! واليوم لن نتحدث عن تلك المعاناة، اللهم إلا باستثناء ما يتصل بالأساليب التي أبدعها ذلك الشعب الأسطوري في سياق عملية تكيفه السياسي الصامد مع الواقع الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي.
تتم عملية التكيف الفلسطيني هذه وفق نموذج خاص للنضال التحرري. نموذج له هويته ومقوماته المستقلة بحيث جمع، إلى جانب النضال المسلح والعصيان المدني المعروفين عالميا، شكلا جديدا لمقاومة الاحتلال يمكن أن نطلق عليه اسم: "الانتفاضة المتجددة" منذ القرن قبل الماضي في عام 1882، مرورا بالعامين 1936 – 1939، وليس انتهاء بانتفاضة 2000. هذا مع العلم بأن الشعب الفلسطيني هو، وحده، الذي أدخل كلمة "انتفاضة" إلى قواميس العالم ولغاته. ووفقا للمناضل "الراحل عنا/ المقيم فينا" فيصل الحسيني فإنه منذ 1987، قام الشعب الفلسطيني بانتفاضة مدنية أساسا (ثورة أطفال الحجارة) ثم اتخذت طابعا عسكريا محدودا، لكنها بقيت انتفاضة بدون مفاوضات (1987 – 1993). ثم خاض غمار المفاوضات بدون انتفاضة (1993 – 2000). وهو اليوم يشارك منذ (سبتمبر 2000) في انتفاضة، عسكرية أساسا ومدنية أيضاً، مع خوضه غمار المفاوضات كلما استطاع إلى ذلك سبيلا!. أما السمة العسكرية الغالبة لانتفاضة اليوم فقد جاءت ردا على استمرار الاحتلال واندلاع بركان القتل الإسرائيلي يوم 28/9/2000 حين قام شارون بزيارته الاستفزازية للمسجد الأقصى.
ولعل أهم ما يميز النضال الفلسطيني الراهن السمات التالية:
1- انخراط طبقات وأفراد ومؤسسات المجتمع الفلسطيني في عملية صمود ومقاومة للاحتلال حين لعبت التنظيمات المجتمعية (الحديثة والقديمة – السياسية والاجتماعية) أدوارها المتممة بقدر معقول من التناغم (تمنينا لو كان أكبر) لتقليص الخسائر طالما استعصى تعظيم المكاسب.
2- قدرة المجتمع الديناميكية لإعادة هيكلة آليات تكيفه وتعديل أساليب عيشه ليتجاوز محاولات سحقه كمجتمع من قبل احتلال تمادى في ممارساته التعسفية بحيث أصبح "آلة تدمير" شاملة لإنجاز أهداف الصهيونية وبخاصة الليكودية بل تلك الأكثر يمينية.
3- التحام القوى السياسية في المجتمع الفلسطيني على قاعدة هدف: التحرر الوطني - الجامع المشترك الأعظم لجميع منظماته بعيدا عن التشرذم التنظيمي النابع من، والمبني على، الفروقات الأيديولوجية والسياسية.
4- تنوع أشكال النضال بحيث شملت المواجهات المسلحة والعمليات الجهادية/ الانتحارية/ التفجيرية (وفقا للتسميات المتباينة) والمظاهرات والاعتصامات والإضرابات بشكل استنزف جزءا مهما من الموارد الإسرائيلية المادية والمعنوية.
5- إعادة رسم خريطة الصراع وميادينه بحيث لا تشكل السطوة العسكرية الإسرائيلية العامل الوحيد في حسم ذلك الصراع. وغني عن الذكر أن ممارسات المدرسة الباراكية – الموفازية التي استمرت، بل توسعت، في عهد المدرسة الشارونية – الموفازية، إنما استهدفت استخدام كثافة نارية تدميرية عالية لتكسير مفاصل السلطة والمجتمع الفلسطينيين وصولا إلى تكسير الإرادة الفلسطينية (وفقا لشعار: "دعوا الجيش الإسرائيلي ينتصر"!).
ولأهمية السمة الأخيرة هذه، يجب تسليط بعض الضوء الإضافي عليها سواء على الصعيد الدولي أو المحلي. فدوليا، نلاحظ أن الصراع العربي/ الإسرائيلي هو من أكثر الصراعات تأثرا بالعوامل الدولية. فإقامة إسرائيل كانت نتيجة قرار دولي جاء ضمن ظروف وتوازنات معينة. كذلك، فإن الدعم الخارجي (المملكة المتحدة وفرنسا في الماضي، والولايات المتحدة راهنا) شكل خيط الولادة ثم خيط الحياة لإسرائيل، وبالتالي فإن خسارتها لحربها السياسية والأخلاقية دوليا هي هزيمة لها آثارها على المدى البعيد. وخير دليل على ذلك نتائج الاستفتاء الأخير في أوروبا الذي وضع إسرائيل في مقدمة الدول المهدّدة للسلام. ومن المهم أيضا ملاحظة اقتران التأييد للدولة العبرية عالميا بمراكز القوى المتطرفة والانعزالية دوليا. هذا مع عدم إنكارنا نجاح الصهيونية منذ بدء الحرب العالمية الثانية بربط نفسها مع القوى الحرة والليبرالية عالميا. غير أن خسارة الدولة الصهيونية لمعظم ما حققته تاريخيا مع الأحزاب والقوى والمنظمات الليبرالية والاشتراكية الليبرالية، وكذلك تزايد تقارير المنظمات الدولية، بل حتى الإسرائيلية، ذات الشأن حول الانتهاك الإسرائيلي المستمر لحقوق الإنسان الفلسطيني (والعربي) إنما يؤشر إلى إنجاز إضافي للانتفاضتين الأولى والثانية مع الاعتراف بأن البعد العسكري في الكفاح الفلسطيني (وبخاصة العمليات