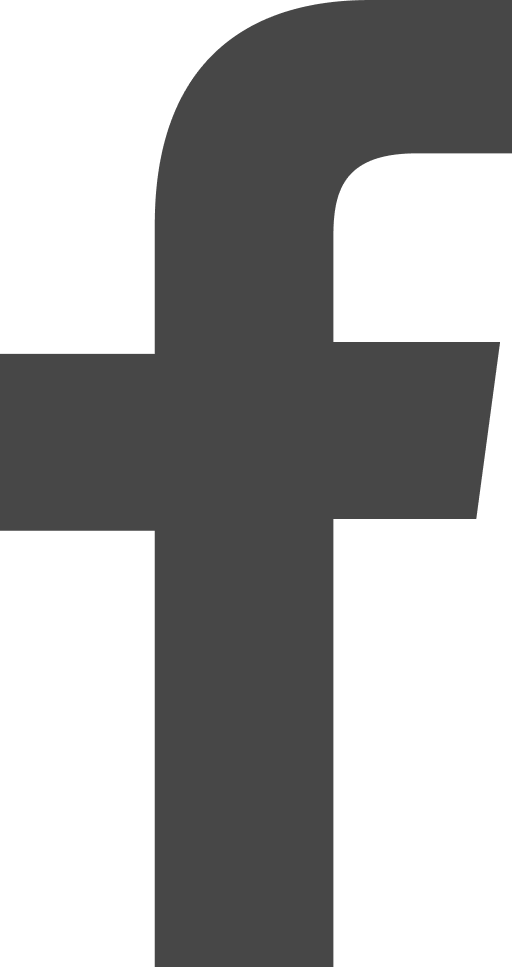يحاول المفكر وعالم الإسلاميات السعودي زكي الميلاد في كتابه "من التراث إلى الاجتهاد"، أن يتفحص مجدداً موقع العقل أو النظر العقلي في مناهج وطرائق المفكرين الإسلاميين، وفي رؤاهم حول قضايا الإصلاح والتجديد والحداثة. ويتتبع الكتاب أزمنة فكرية تنتمي إلى أربعة عصور أو مراحل تاريخية؛ زمن ينتمي إلى العصر الوسيط، وزمن ينتمي إلى العصر الحديث، وزمن ينتمي إلى ما بعد قيام الدولة العربية الحديثة في النصف الثاني من القرن العشرين، وزمن ينتمي إلى تحولات العقدين الأخيرين من القرن العشرين. وقد شهدت هذه الأزمنة تحولات عميقة أثرت على مسارات الفكر الإسلامي وغيرت من اتجاهاته ومسلكياته ومرجعياته. ففي العصر الوسيط تحددت للعلوم والمعارف الإسلامية صياغات ومرجعيات فكرية تميزت بتأثير فاعل، ومازالت نشطة في حياتنا الثقافية المعاصرة؛ وهي أربع مرجعيات أساسية كما يصنفها المؤلف: كلامية (مثل المعتزلة والأشاعرة والخوارج) وأصولية (كأهل الحديث وأهل الرأي) وفقهية (وهي المذاهب الأربعة: الشافعية والحنبلية والمالكية والحنفية)، وسلوكية (الصوفية مثلا).
وعلى رغم ذلك شهد فكر العصر الوسيط الإسلامي تحولاً حاداً في مسلكياته ومرجعياته، خاصة مع ظهور أبو حامد الغزالي في القرن الخامس الهجري، ثم أحمد بن تيمية في القرنين السابع والثامن. فقد كان الغزالي يعتقد عن نفسه، كما يقول الدكتور فهمي جدعان، "أنه واحد من المصلحين الذين أنيط بهم إحياء الإسلام عند رأس المئة الخامسة للهجرة، لهذا كتب مؤلفه العظيم إحياء علوم الدين"، وأسس ما أصبح يعرف بطريقة المتأخرين في علم الكلام، "وهي الطريقة التي مكنت علم الكلام الأشعري من التحرر من منهج المعتزلة المفضل" حسب تعبير محمد عابد الجابري. أما ابن تيمية الذي انتقد الفلسفة والمنطق، وساهمت حركته الفكرية والاحتجاجية في الحد من تطور وتأثير حركة الغزالي الفكرية، فيرى المؤلف أن ما قام به من نقد ومراجعة للمعارف والأفكار في عصره، تداخلت فيه نزعته العلمية بنزعته النفسية، ولم تكن الحدود المعرفية والموضوعية في نقده على درجة عالية من الوضوح. ومع ذلك فان الفكر الإسلامي المعاصر، كما يقول المؤلف، مازال يحمل مظاهر الانقسام في المنازع بين الغزالي وابن تيمية، ولم يستطع تجاوز أزمته وحيرته، إذ من الصوفية انتهى إلى السلفية.
وفي صدد حديثه عن سمات وملامح الفكر الإسلامي الحديث، يؤطر زكي الميلاد زمنياً ذلك الفكر باعتباره تشكل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، مرتبطاً بواقع الوجود الاستعماري وما بعد سقوط الخلافة العثمانية، ثم قيام الدولة القطرية العربية في النصف الثاني من القرن العشرين. ويرى الميلاد أن أكثر العوامل تأثيراً على تطورات الفكر الإسلامي الحديث هم رجالات ذلك الفكر، مثل رفاعة رافع الطهطاوي وجمال الدين الأفغاني وخير الدين التونسي ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا... لكن "أهم هؤلاء جميعا باتفاق جميع المتخصصين هو جمال الدين الأفغاني"، كما يقتبس المؤلف من قيس العزاوي. فقد استطاع الأفغاني أن يبعث نهضة في أمة متعددة المذاهب والقوميات واللغات، وكان أول من شكل انتفاضة الشرق ضد الغرب في المجال السياسي، وكان طرفاً مؤثراً وفاعلاً في الساحة الإسلامية، أما عن رؤيته فيقول المؤلف إنها كانت أبرز وأهم رؤية في توصيف المنطقة الإسلامية آنذاك، فكرياً وسياسياً، ويلاحظ أنه بينما ارتبط الطهطاوي بدولة محمد علي باشا، وارتبط خير الدين التونسي بالدولة العثمانية، وارتبط محمد عبده بعد عودته الأخيرة إلى مصر بالجهاز الرسمي للدولة... فإن جمال الدين الأفغاني كان ارتباطه شديداً وواسعاً بالمجتمع والدولة في أقطار عديدة من العالم الإسلامي؛ من تركيا إلى إيران ومصر والعراق والهند وأفغانستان.
ويتناول المؤلف علاقة الإمام محمد عبده وأستاذه الأفغاني ويقول إنها بلغت طورها الأخير بعد ما أظهر عبده شخصيته المستقلة وبدأ يراجع "فكرة الجامعة الإسلامية"، فتحول من الدفاع عن الدولة العثمانية ككيان عام للمسلمين إلى الاهتمام بإصلاح المجتمع المصري. كما يبحث بحثاً وافياً حول مفكر نهضوي آخر هو عبد الرحمن الكواكبي، ويقول إن الأفكار التي قدمها الكواكبي اتصفت أكثر من غيرها من تصورات المصلحين والمفكرين في عصره بالتركيز والتحديد والضبط والوضوح، بل إن رؤيته في تحليل وتفكيك الاستبداد السياسي، هي أنضج الرؤى التي أنتجها الفكر الإسلامي الحديث. أما محمد رشيد رضا، فقد عبر عن صور وأنماط الفكر الإسلامي، إذ بدا متصوفاً في المرحلة الأولى من حياته، ثم أصبح إصلاحياً، لينتهي سلفياً في آخر حياته.
وكذلك يعقد الكتاب فصولاً حول ثلاثة مفكرين إسلاميين معاصرين، هم السيد محمد باقر الصدر الذي كشف للأوساط العلمية والأكاديمية "قيمة الفقه الإسلامي وثروته العلمية"، وذلك حينما ألف كتابيه "فلسفتنا" و"اقتصادنا". والشيخ مرتضي المطهري الذي يعد أحد أعمدة البناء الفكري لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد اتصف خطابه بمكونات نقدية وإصلاحية