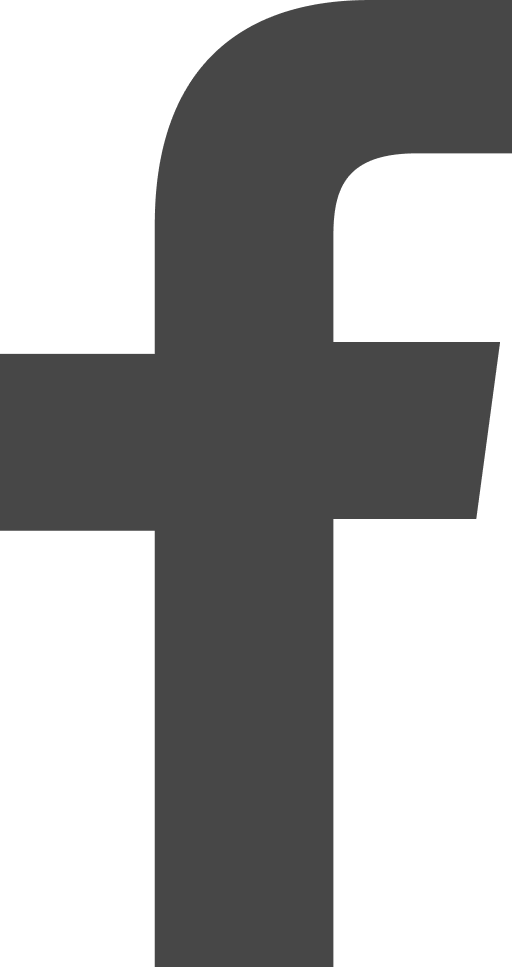آيات الحجاب ثلاث: واحدة في سورة الأحزاب وهي أسبق نزولا، واثنتان في سورة النور. وكتمهيد لفهم الظروف الاجتماعية التي نزلت فيها هذه الآيات، نقول:
كان عمران القرى في كثير من المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية التي تمتد من الخليج شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا –وضمن ذلك مكة والمدينة (يثرب قبل الإسلام)- يتميز بطرق يسقف بعض أجزائها. وفي الأجزاء المسقوفة، ويسمى الواحد منها سقيفة، جرت عادة سكان هذه القرى أن يجلس الرجال في مجالس على جانبي الطريق للاستراحة والاستظلال من القيظ وتبادل الأخبار وما أشبه. وكانت المرأة لا تغادر منزلها إلا لقضاء حاجة ضرورية. وإذا هي مرت في مثل هذه الطرق اتجهت إليها الأبصار، وربما تعرضت للغمز واللمز في مجالس الشباب. ولما كانت المنازل في هذا النوع من العمران لا تشتمل على مراحيض، فإن النساء كن يخرجن لقضاء الحاجة في الخلاء، وكن يصطحبن معهن إماءهن كمرافقات في الطريق. ويقول المفسرون إن بعض نساء النبي والصحابة قد تعرضن لمثل هذه التحرشات، فشكون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سبب نزول قوله تعالى: "يٰأَ أيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ، ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيما" (الأحزاب 59).
أما الهدف من "إدناء جلابيبهن عليهن" فواضح، وهو "أن يعرفن"، أي أن يميز الرجال والشبان المتحرشون بين النساء الحرائر وبين الإماء المرافقات لهن، فلا يتعرضوا للحرائر بسوء.
وأما "الجلباب" فقد اختلف فيه المفسرون، ويرجع هذا الاختلاف إلى تنوع "الحجاب" السائد في ذلك العصر، صنف عربي الأصل، وصنف فارسي الأصل، وصنف آخر موروث عن اليونان والرومان الخ. ومن هنا قال بعضهم إن على المرأة الحرة أن تلف جسمها في إزار (حايك) ولا تترك إلا فتحة بحجم العين ترى من خلالها طريقها، وقال آخرون تلفه إلى جبهتها، وقال آخرون تترك الوجه كله، وذكروا حديثا نبويا يبيح للمرأة إظهار ذراعها إلى النصف الخ، وواضح أن الخطاب في الآية المذكورة هو للنساء دون الرجال.
بعد الآية المذكورة جاءت "سورة النور"لتعمم الخطاب على المؤمنين والمؤمنات أولا، ولتوضح ثانيا أن المقصود هو إخفاء الزينة الباطنة دون الظاهرة، ولتحدد ثالثا من هم الذين يجوز للمرأة أن تظهر أمامهم بزينتها الباطنة. فقال تعالى: "قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَآئِهِنَّ أَوْ آبَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ (كالأبله والعجز جنسيا) أَوِ الطِّفْلِ (الغلمان) الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَآءِ (لم يتعرفوا عليها بعد لصغرهم) وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ (كالخلخال) وَتُوبواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (سورة النور30-31).
أما عن قوله تعالى" وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ"، فيقول المفسرون: إن الخمار ثوب تضعه المرأة على رأسها كله أو بعضه وتتركه يتدلى على ظهرها، وأما "الجيوب" فهي جمع "جيب" وهو فتحة العنق في القميص قد تطول إلى الصدر وقد تقصر، وقد اختلفوا هل المطلوب من المرأة أن ترخي الخمار على وجهها وصدرها أم تلفه من وراء ظهرها وتحت إبطها لتغطي به الجيب على الصدر. واختلف المفسرون أيضا في تحديد الفرق بين "الزينة الظاهرة" و"الزينة الباطنة". فمنهم من حصر الزينة الظاهرة في الثياب فقط تلقيه المرأة على جسمها كله، ومنهم من جعل الزينة الظاهرة تشمل الوجه والكفين، ومنهم من أضاف الذراع أو نصفه وذكروا في هذا حديثا نبويا. كان منهم من اعتبر الضرورة فأباح للمرأة أن تبدي من أعضائها حسب الحاجة، كما هو الحال في الفحص الطبي والتوليد وعندما تعجن الخبز أو تغسل الثياب أو تتحدث مع الرجال. وقد صاغ ابن عطية ذلك بعبارة عامة فقال: "ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تُبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بدّ منه، أو إصلاح شأن ونحو ذلك. فـ«ما ظهر» على هذا الوجه مما تؤدّي إليه الضرورة في النساء فهو المعفوّ عنه".