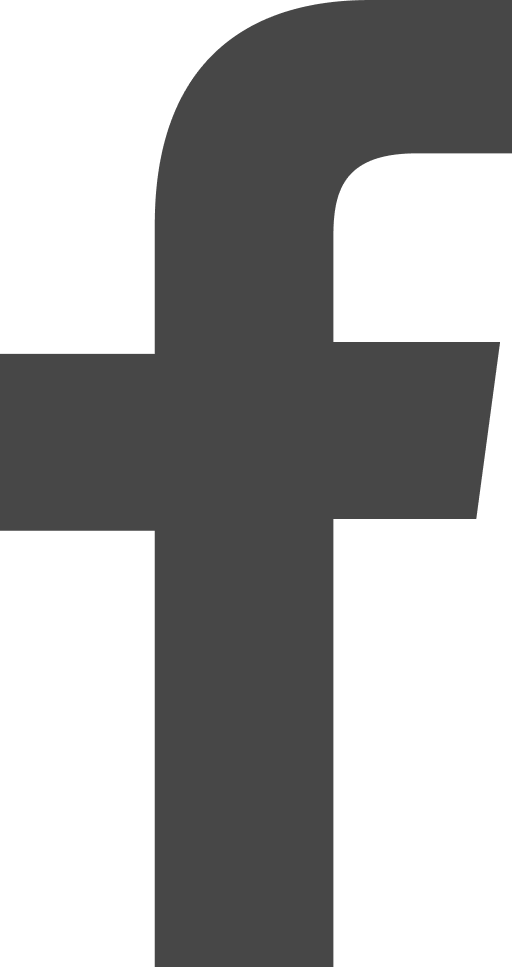انتهينا في المقال السابق إلى أن المجال التداولي لمفهوم "الوحي"، في خطاب العرب قبل الإسلام، لم يكن يتضمن المعنى الذي جاء به القرآن، وهو أن يبعث الله ملاكا رسولا، هو جبريل بالتحديد، ينقل كلام الله إلى الإنسان الذي اختاره الله رسولا إلى البشر. وقلنا إن الوحي بهذا المعنى لم يكن للعرب علم به، لا في معهودهم الخاص ولا فيما كان يمكن أن يعلموه بواسطة أهل الكتاب. ونريد في هذا المقال أن نشرح كيف أن مفهوم النبوة بالمعنى الإسلامي، وهو قرين مفهوم الوحي، كان هو الآخر غائبا عن مجالهم التداولي اللغوي.
اختلف أهل اللغة في الأصل الذي اشتق منه اسم "نبوة" فانقسموا فريقين: فريق يقول إنه مشتق من فعل "أنبأ" بمعنى "أخبر"، والاسم منه: "نبيء" بالهمز. وبالتالي فـ"النبيء" هو الذي يأتي بالخبر. أما الفريق الثاني فيرى أن الهمز فـي "النَّبـيءِ" لغة رديئة، وهي لغة أهل مكة، وقليلة الاستعمال وإن كان القـياس لا يمنع من ذلك. وفي هذا الإطار يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب شخصا دعاه "يا نبيء الله" بقوله: "لا تَنْبِر باسْمي، فإِنما أَنا نَبِـيُّ الله". وفـي رواية: "قال لستُ بِنَبـيءِ اللَّهِ ولكنِّـي نبـيُّ الله".
والقائلون بعدم الهمز يرون أن لفظ النبيّ "أُخِذَ من النَّبْوةِ والنَّباوةِ، وهي الارتفاع عن الأَرض". وبالتالي سمي النبي نبياً "لارْتِفاع قَدْره ولأَنه شُرِّفِّ على سائر الخلق". وأضاف بعضهم: "النَّبيُّ الطَّريقُ، والأَنْبِياء طُرقُ الهُدَى". وينسب إلى عبدالله بن عمر بن الخطاب قوله: "ما همز رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبوبكر ولا عمر ولا الخلفاء، وإنما الهمز بدعة ابتدعوها من بعدهم". وبالنظر إلى هذا الاختلاف في تحديد معنى "النبي" في اللغة العربية يتضح أن المعنى الإسلامي لهذا اللفظ قد نشأ مع الإسلام، مثله مثل كثير من المصطلحات الشرعية التي اختص معناها في الإسلام بمضامين لم تكن تعطى لها قبل الإسلام كـ"الصلاة" و"الزكاة" و"الغسل" والوضوء" الخ. ومن هنا ارتأى بعض المستشرقين أن لفظ "النبي" في الاصطلاح الإسلامي مأخوذ من العبرية Nabi (نافي) وهو يدل على "الرائي" (قارئ المستقبل).
وأما الرسول فهو من "الرَّسل"، ويذهب الراغب الأصفهاني في كتابه "مفردات غريب القرآن" إلى القول: أصل الرسل: الانبعاث (=الإرسال) على التؤدة ويقال: ناقة رسلة: سهلة السير... وقيل: على رسلك: إذا أمرته بالرفق". ومنه اشتق "الرسول" (بمعنى مرسول)، أي "مُتحمِّل (حامل) القول والرسالة". وقد استعمل لفظ الرسول في القرآن استعمالات متعددة. استعمل للواحد كقوله تعالى: "لقد جاءكم رسول من أنفسكم" (التوبة 128)، واستعمل لأكثر من واحد كقوله: "فقولا إنا رسول رب العالمين" (الشعراء/16 )، كما استعمل، تارة يراد به الملائكة كقوله تعالى: "ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى" (العنكبوت 31)، وتارة يراد به الأنبياء، مثل قوله: "وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل" (آل عمران 144). كما استعمل الإرسال في القرآن في الأشياء المحبوبة والمكروهة، سواء بسواء، كإرسال الريح، والمطر، نحو: "وأرسلنا السماء عليهم مدرارا" (الأنعام 6)، وقد يكون ببعث من له اختيار، نحو إرسال الرسل، قال تعالى: "ويرسل عليكم حفظة" (الأنعام 61)، وقد يكون ذلك بالتخلية وترك المنع، نحو قوله: "ألم ترَ أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاً" (مريم 83)، كما يستعمل الإرسال في مقابل الإمساك. قال تعالى: "ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده" (فاطر 2).
هذا ويميزون بين النبي والرسول على أساس أن النبي قد يأتيه الوحي ولا يكلف بتبليغه، على عكس الرسول المكلف بتبليغ رسالته. وعلى هذا فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يقولون إن النبوة يغلب عليها الإضافة إلى النبي، فيقال نبوة النبي لأنه يستحق منها هذه الصفة. أما الرسالة فتضاف إلى الله لأنه هو المرسل. ومع ذلك يقال نبي الله كما يقال رسول الله.
هذا في اللغة واصطلاح القرآن. أما في الفكر الإسلامي عموما فالكلام حول صفات النبي وحقيقة النبوة يختلف باختلاف الفرق المذهبية والاتجاهات الفكرية. ويمكن القول بصفة عامة إن اهتمام الفرق الكلامية كان مركزا حول إثبات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وما به تثبت؟ وحول ما يميز النبي عن سائر البشر مثل تلقي الوحي، وكيفية التلقي، واحتمال تعرضه للنسيان، وهل هو معصوم أم غير معصوم؟ كما دار كلامهم حول المنقول والمعقول وكيفية التعامل معهما. أما الفلاسفة فقد انشغلوا أكثر ببيان العلاقة بين النبي والفيلسوف، بين ما يعطيه العقل (الفلسفة) وما يعطيه الوحي (الدين).
لنبدأ بالتعرف على رأي أهل السنة.
مصطلح "أهل السنة" يستعمل بمعنيين: عام، وخاص. فإذا قيل في مقابل "الشيعة" و"الخوارج" فهو يعم من تسموا في العهد الأموي بـ"أهل السنة والجماعة"، وهم الذين تفرع عنهم كل من المعتزلة والأشاعرة. هذا في المعنى العام. أما في المعنى الخاص فيقال للإشار