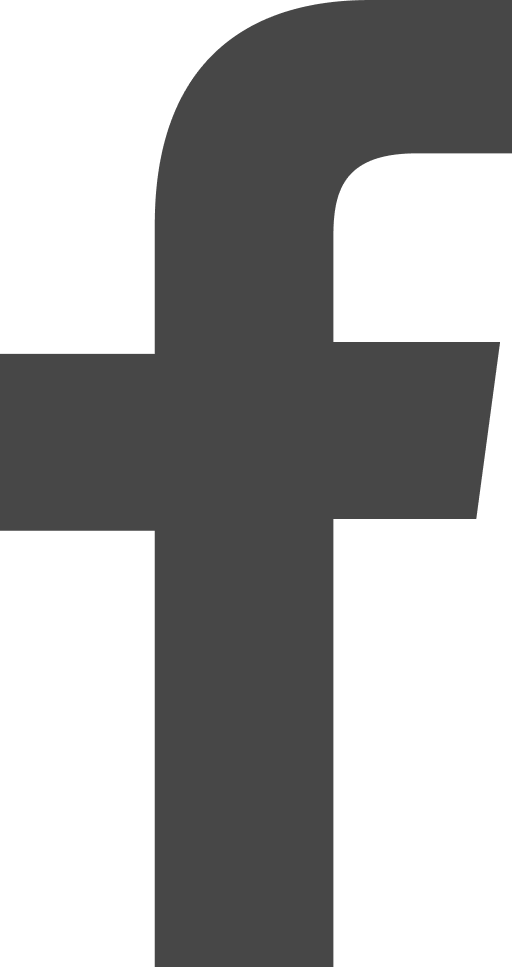يحاول الدكتور أحمد جدي في كتابه "محنة النهضة ولغز التاريخ في الفكر العربي الحديث والمعاصر"، الإمساك ببؤر التخلف العربي ومجالات العلة والخلل القائم والمتواصل بين الآمال والواقع، فيعرض لجوانب من ذلك الخلل معتمدا على نماذج وعينات بارزة من رجالات القلم والسياسة والفكر في تاريخ العرب خلال عهديه الحديث والمعاصر، ويتناول بعض الأبعاد الداخلية لذلك التاريخ في علاقته المضطربة مع الغرب، أي ما أفرزته في مجموعه مأساة تاريخية تمثلت في وعي النخب العربية بالتخلف وفي الإدراك المحدود لإشكالية الإصلاح والنهضة، وكأن ذلك إنما يحدث ضمن إرهاصات التاريخ أو في مكره أو في لغزه!
وتتمفصل الدراسات الثماني التي يضمها الكتاب عبر قسمين؛ أولهما يهتم بالتوقف عند بعض العلامات الفكرية والسياسية والحضارية في التاريخ العربي الحديث، بينما يهتم الثاني بحقبة التاريخ العربي المعاصر وبعض علاماته كذلك. وهكذا تهتم أولى دراسات القسم الأول، بالبحث في مسألة حضور "الثورة الفرنسية في الفكر العربي الحديث" وكيفية تعامله معها، من خلال قراءة متفحصة لما كتبه كل من القس حنانيا المنير ونقولا الترك وحيدر الشهابي، ليصل المؤلف بهذا الصدد إلى استنتاج بأن ذلك الحضور كان "سطحيا ومحدودا ومشوها ومؤدلجا"، باعتبار أن الذين "عسكوه" في كتاباتهم إنما هم من النخبة المحظوظة اجتماعيا وثقافيا وسياسيا، مما يكشف ليس فقط عن طبيعة النخبة العربية في العصر الحديث بل أساسا عن "تأخر الكتابة التاريخية والفكر التاريخي في المجتمع العربي" في تلك الفترة، ومن ثم فإن ذلك المجتمع، ومن ضمنه نخبته المفكرة والكاتبة، لم يعش زمن الثورة ومرحلة التحولات العميقة ولم يكن بالتالي "حديثا" في علاقاته وطرائقه وآلياته.
وتحاول دراسة أخرى في الكتاب ضبط إشكالية المسألة الاقتصادية وملامحها في الفكر العربي الحديث، انطلاقا من نصوص وآثار اثنين من أبرز رجالات الإصلاح والفكر في تونس خلال القرن التاسع عشر؛ هما أحمد بن أبي الضياف وخير الدين التونسي باشا. فرغم أن الرجلين لم يقدما نظرية اقتصادية أو مدرسة في مجال الاقتصاد السياسي، إلا أنه للاقتصاد وظواهره مكانة محورية في فكرهما، حيث جاءت كتاباتهما مليئة بالمصطلح الاقتصادي، وكان تعرضهما للمسائل الاقتصادية "تعرضا واعيا وشاملا ويعكس إدراكا لأهمية الاقتصاد ودوره في حياة المجتمع".
كما يفرد المؤلف دراسة خاصة عن "موقف أحمد بن أبي الضياف من حركة علي بن غذاهم"، والتي بدأت عام 1864 كتحرك من جانب المجتمع التونسي ضد السياسة الجبائية للدولة، حيث أرخ ابن أبي الضياف بتفصيل واف لتلك الحركة. إلا أن المؤلف يهتم بموقف ابن أبي الضياف من الحركة باعتباره أحد رجالات الدولة الحسينية الذين عبروا عن موقف مغاير تماما للموقف الرسمي الذي كان السبب الرئيسي والمباشر في اندلاع الثورة، من هنا "لا يجوز لنا أن نعتبر أن ابن أبي الضياف كان دائما في صف البلاط ومساندا له في كل الظروف وكل المواضيع".
وتتناول دراسة أخرى مثقفا "نهضويا" آخر هو عبدالرحمن الجبرتي "بين سلطان الفقه وسلطان التاريخ" وتتساءل: كيف تحول الجبرتي من الفقه إلى الكتابة التاريخية؟ وكيف نقرأ الجبرتي؟ لقد كان صاحب كتاب "تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار" ذا تكوين أزهري، لكن ذلك لم يعزله عن الحياة وعن وعي معين بالتاريخ والدين والغرب، بل انتقل إلى الكتابة التاريخية تاركا لنا مدونة ثمينة كتبها "تحت تأثير وفعل أزمة عامة تمثلت في حملة نابليون بونابرت على مصر"، أي الحملة التي اعتبرها هو حدثا عظيما ومحنة جديدة فرضت نفسها عليه فوثقها في "أوراق متسقة النظام".
أما القسم الثاني من الكتاب وهو "في التاريخ العربي المعاصر"، فيستهله المؤلف بدراسة عن "إشكالية النهضة في الفكر العربي المعاصر: عمر فاخوري مثالا"، وفيه يؤكد على انتماء فكر ذلك الرجل ومختلف إنتاجه وتجاربه إلى الفكر القومي بفضاءاته وآلياته ومصادره وتساؤلاته الكبرى، ومن هذه الزاوية يحاول المؤلف تأطير فكر عمر فاخوري ضمن سياق المساهمات العربية المعاصرة المرتبطة بالنهضة وشبكة علاقاتها بمستويات أخرى. كما نطالع في القسم ذاته دراسة أخرى تبحث في "التاريخ التونسي المعاصر بين الشفوي والمكتوب: الطاهر الحداد مثالا"، وذلك من خلال كتابه "العمال التونسيون وظهور الحركة النقابية"، إذ طرح على الحداد نشاطه النقابي مهمة الكتابة أو الانتقال من طور الشفوي إلى مرحلة الكتابة والتوثيق والتأريخ، وبذلك بدا عالمه "مجال صراع مستمر - خفي وجلي- ومتوتر ومتعدد المستويات والأشكال بين سلطة الواقع والتاريخ وسلطة القول والشفوي وسلطة المكتوب الذي يبقى".
وتعميقا لاستنتاجاته من حالة الحداد، يحاول المؤلف في دراسة أخرى كشف بعض الجوانب لعلاقة النخبة المغاربية المعاصرة بالسلطة عبر مؤسسة السجن، ومن خلال نموذج دولة الاستقلال ونموذج المفكر المبدع/ المناضل السياسي اليساري ممثلا في عبد اللطيف اللعبي الذي عاش سجينا ثماني سنوات من حياته، واج