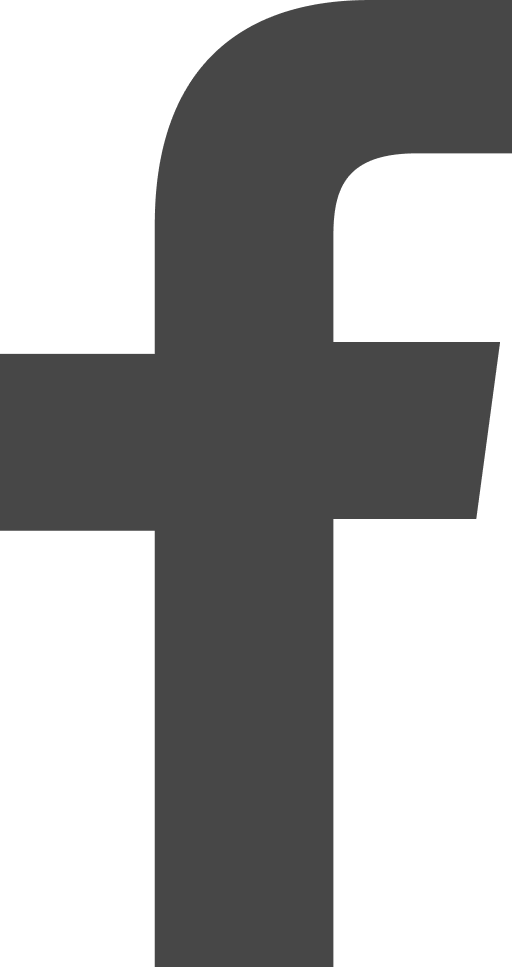تناولنا في مقالٍ سابقٍ رؤية علي عزت بيجوفيتش لثنائية الطبيعة البشرية، ونقده للمفهوم المادي للإنسان والطبيعة· وترتبط هذه الرؤية ارتباطاً وثيقاً بنظرته إلى الثنائية الإسلامية بتجلياتها المتعددة، سواء على مستوى بنية القرآن الكريم أو على مستوى المفاهيم والأفكار الإسلامية·
فعلى سبيل المثال، تظهر الثنائية الإسلامية التفاعلية أو التكاملية في الرؤية الإسلامية لمفهوم الأمة· فالإسلام، كما يقول علي عزت بيجوفيتش، ليس مجرد أمة بالمعنى البيولوجي أو الإثني أو العرقي، وليس حتى جماعة دينية بالمعنى الروحي الخالص للكلمة، وإنما هو دعوة لأمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أي تؤدي رسالة أخلاقية· وانطلاقاً من ذلك يؤكد علي عزت بيجوفيتش أنه لا يمكن إغفال المكون السياسي للإسلام وقصره على النزعة التصوفية الدينية، لأن في هذا تكريساً صامتاً للتبعية والعبودية· ولا يمكن كذلك إغفال المكون الديني (الروحي) في الإسلام، لأن في هذا رفضاً صامتاً لتحمل الأعباء الأخلاقية· إن الإسلام الحقيقي ليس مجرد دين روحي أو طريقة حياة فقط، بل هو منهج ومبدأ لتنظيم الكون أكثر منه حلاً جاهزاً، إنه المركب الذي يؤلف بين المبادئ المتعارضة· إن الإسلام ليس ديناً ودولة كما يقول البعض (الذين وقعوا صرعى التعريفات العلمانية الغربية، والتي تعطي مركزية هائلة للدولة)، بل هو دين ودنيا يتوجه إلى الجانبين الروحي والمادي في الإنسان·
وتقودنا هذه الثنائية إلى فكرة جوهرية في الإسلام، وهي ميله إلى دمج الفن بالتكنولوجيا، وتتحقق هذه النزعة التركيبية بأكبر قدر من الثبات في فن العمارة· فمن بين الفنون الكبرى استوعب الإسلام فن المعمار وأولاه أكبر اهتمام· ولعل ذلك يرجع إلى أنه أقل الفنون تجريدية، فالفنون التجريدية تؤكد على فردية الإنسان أكثر مما ينبغي (أما الفنون التي تنبع من منطلقٍ روحي خالص فتؤكد الجوانب الأخرى في الإنسان أكثر مما ينبغي)· وكلا الموقفين مضاد لنزعة التوازن التي يحرص عليها الإسلام· أما الفن المعماري الإسلامي فلا يحلق في التجريد ولا يسقط في النفعية، وإنما هو فن وظيفي معني ومهتم بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية الاجتماعية والفردية·
وتتبدى الثنائية الإسلامية في موقف الإسلام من تحريم الخمر، فالإسلام حرَّم الخمر لأنها شر اجتماعي· وليس في الدين (الروحي) المجرد شيء ضد الخمر· بل إن بعض الأديان استخدمت الكحول كعامل صناعي يساعد على استحضار النشوة، شأنه في ذلك شأن الإظلام في المعابد ورائحة البخور العطرة، فكلها وسائل تؤدي إلى هذا النوع من الخدر المطلوب· أما الإسلام فقد حرم الخمر واعتبرها من الكبائر، ذلك لأن الإسلام سلك مسلك العلم لا مسلك الدين المجرد·
وتتمثل الثنائية نفسها في فكرة العدالة· فالعدالة فضيلة على المستوى الشخصي والمستوى الاجتماعي، وهي تجمع بين فكرة الإنصاف والقوة· ويقارن علي عزت بيجوفيتش بين العدالة وفكرة الزواج وهما فكرتان تنطويان على قدر من الخشونة الظاهرية، ولكنهما توفران للإنسان حياة أكثر صفاء وأكثر استقامة مما يوفره الدين الروحي المجرد الذي يتطلب العزوبة الكاملة، أو الرؤى المادية التي تسمح بالحرية الجنسية الكاملة (من الناحية النظرية)·
وتتبدى الثنائية الإسلامية في اهتمام الإسلام بكلٍ من القراءة والكتابة باعتبارهما أقوى محرك للمجتمعات الإنسانية· فلا غرابة أن يُعنى بهما الوحي، فكان الأمر بالقراءة (في سورة العلق) أول ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم من آيات القرآن· وقد تبدو الكتابة غريبة عن الدين (الروحي المجرد)، فقد بقيت الأناجيل تقليدًا شفهيا لفترة طويلة من الزمن· وعلى العكس من ذلك، فقد اعتاد محمد صلى الله عليه وسلم أن يملي آيات القرآن على كُتَّاب الوحي فور نزولها، لكي لا يتسلل إليها التحريف أو التبديل·
ويشير علي عزت بيجوفيتش إلى أن الثنائية التكاملية الإسلامية تتمثل في أن للإسلام مصدرين أساسيين: هما القرآن والسنة النبوية، فهما يمثلان كلاً من الإلهام والخبرة، الخلود والزمن، التفكير والممارسة، الفكرة والحياة· ثم يتناول علي عزت بيجوفيتش تجليات النظام الثنائي في حالة كل من مكة وغار حراء· فقد كانا يمثلان عند لحظة ظهور الإسلام التضاد بين الواقعي والعالم الباطني، بين الفاعلية والتأمل· وقد تطور الإسلام على مرحلتين، الأولى في مكة والثانية في المدينة، وهما فترتان سُجل اختلافهما في الروح والمعنى في كل ما كتب عن تاريخ الإسلام· وهنا نصادف التضاد نفسه أو التناقض الظاهري في إطار الإيمان والسياسة·· مجتمع الإيمان ومجتمع المصالح·
وتتبدى الثنائية في بنية القرآن نفسه، الذي يرى البعض أنه من الناحية الموضوعية لا يتبع نظاما محدداً، ويبدو وكأنه مركب من عناصر متناثرة· ولكن، لابد أن يكون مفهوماً بادئ ذي بدء، أن القرآن ليس كتاباً أدبياً، وإنما هو منهج حياة· والإسلام نفسه طريقة حياة أكثر من كونه طريقة في التفكير· إن التعليق الوحيد الأصيل على القرآن هو القول إنه حياة، وكما نعلم كانت هذه الحياة في نموذج