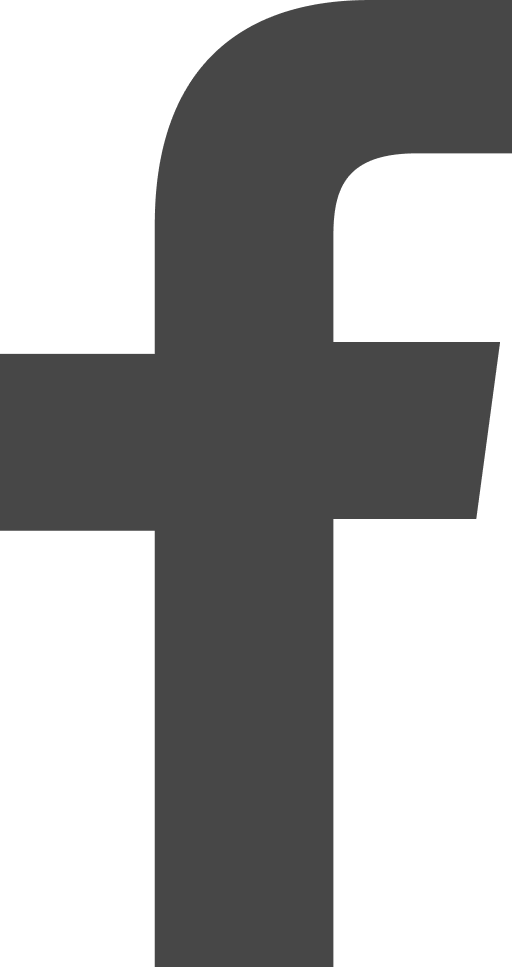تُعد «القومية» واحدة من تلك الكلمات التي غالباً ما تكون مقرونة بصفة. فالقومية يمكن أن تكون «عرقية» أو «اقتصادية»، ويمكن أن تكون «بيضاء» أو «سوداء» أو «مسيحية».. ويمكن أن تكون «يمينية» أو «يسارية»، «معتدلة» أو «متطرفة».. إلخ.
لكن في بعض الأحيان تظهر الأشياء الخام غير مبتورة. فدونالد ترامب يصف نفسه بأنه «قومي»، لكن من دون صفة، ويصوّر أنصاره ذلك على أنه فعلٌ شجاع لا يلقي بالاً لـ«الصواب السياسي». وقد يظن البعض أنهم يعرفون ما يقصده حينما يقول ذلك، غير أن تعريف القومية بمفردها قد ينطوي على بعض الصعوبة، لأن الكلمة تعني أشياءً مختلفة في سياقات مختلفة. فالديكتاتور الذي يضطهد أقليات عرقية في بلاده، والحركة المطالبة بالاستقلال التي تحارب الاستعمار الأجنبي يمكن وصف كليهما بأنه «قومي». و«الأمّة» تصبح مختلفة عن المجموعة العرقية أو الثقافة أو التجمع الجغرافي حينما تسعى إلى نوع من تقرير المصير السياسي، وهذا السعي هو القومية.
ولأن الدول القومية هي الشكل المهيمن من أشكال التنظيم السياسي الموجودة على كوكبنا، فإن القومية بهذا الشكل المحدود هي الشكل المبدئي والأساسي عموماً. وكما قال الفيلسوف التشيكي البريطاني إرنست غيلنر: «يجب أن تكون للإنسان جنسية مثلما يجب أن يكون له أنف وأذنان». أما كيف أصبح هذا هو الوضع المبدئي والأساسي، فتلك هي القصة التي يرويها كتاب «القومية.. تاريخ العالم»، لمؤلفه إريك ستورم، أستاذ التاريخ في جامعة ليدن الهولندية.
والواقع أن الأمر يتعلق بمبحث أكاديمي جد مطروق، كما يقر ستورم. فالمدرسة الفكرية المهيمنة حول نشأة القومية، على الأقل خلال نصف قرن الماضي أو نحو ذلك، هي المدرسة «الحداثية» التي ترى أن الأمم عبارة عن بنيات أحدث مما يعتقده معظم الناس، على اعتبار أنها ولدت من رحم حقبة التصنيع، وظهور وسائل الإعلام المطبوعة، والتعليم الجماعي، والجيوش الوطنية. ويرى الحداثيون، ومن بينهم غيلنر والمؤرخ الإيرلندي بينيديكت أندرسون، مؤلف الكتاب الكلاسيكي «مجتمعات متخيَّلة»، أنه قبل العصر الحديث، لم يكن معظم الناس ينظرون إلى الأمة بمعناها المتداول اليوم. ذلك أنه في العالم ما قبل الحديث، كانت الحدود واللغات والجيوش الوطنية أكثر تحركاً وتحولاً بكثير. ووفقاً للحداثيين، فإن الهويات الوطنية تُبنى من قبل الدول الحديثة التي تتكيف وتسقطها على الماضي البعيد المتخيَّل. وكما يقول سْتُورم، فإن «الأمم هي نتاج القومية وليس العكس»
بيد أن الصين، التي تُعد ثاني أكبر دولة في العالم، تمثّل نموذجاً يتحدى وجهة نظر الحداثيين ويدحضها، على اعتبار أنها طوّرت وحدة ثقافية كبيرة وبيروقراطية وطنية منظمة في عهد أسرة سونغ (960-1279).
سْتُورم ينحاز عموماً إلى الحداثيين، إذ يحاجج بأن الدول القومية، والتي يمكن تعريفها بأنها كيانات ثقافية وسياسية محددة جغرافياً وغير متداخلة، لم تكن موجودة قبل نهاية القرن الثامن عشر، بل يذهب إلى حد افتراض أن مسألة اللغة والثقافة كانت في الواقع «غير ذات أهمية إلى حد كبير» في تطور الدول القومية الأولى. وعلى سبيل المثال، فإن الولايات المتحدة، التي يعتبرها أول دولة قومية حقيقية، وإن كان ذلك غريباً بعض الشيء بالنظر إلى بنيتها الفدرالية، لم تكن لديها اختلافات لغوية أو ثقافية كبيرة مع الإمبراطورية التي خرجت من رحمها. والأمر نفسه ينطبق على الدول القومية الجديدة في أميركا اللاتينية. ويرى سْتُورم أن الربط بين القومية والعرق مضللٌ نوعاً ما.
وعلى مدى أكثر من 350 صفحة، يتتبع سْتُورم كيف تطوّرت القومية في السياسة والثقافة والفنون منذ عصر التنوير إلى ثورات 1848، ثم عبر إمبريالية القرن التاسع عشر والتصنيع، والحربين العالميتين، وموجة إنهاء الاستعمار في أواسط القرن العشرين، ثم صعود العولمة. ويتضمن الكتابُ بعض المقاطع المثيرة للاهتمام، وإن كانت مختصرة أكثر مما ينبغي أحياناً، مثل نظرة سْتُورم إلى الكيفية التي ساعدت بها المعارض العالمية، اعتباراً من منتصف القرن التاسع عشر، في توحيد النموذج العالمي للمواصفات اللازمة للدولة القومية «المتحضرة»: «علَم، ونشيد وطني، وعطلة وطنية، وماضٍ مجيد موثق.. إلخ».
غير أن سْتُورم كان قوياً بشكل خاص، واستطاع تمييز نفسه عن أسلافه من مؤلفي مرحلة أواخر الحرب الباردة، مثل أندرسون وغيلنر والمؤرخ البريطاني هوبسباوم، في الفصول الأولى التي يتتبع فيها الظهور الأول للدول القومية، وفي الفصل الأخير حيث شرح كيف استمرت في عصر العولمة والليبرالية الجديدة.
ذلك أن التسعينيات كانت حقبة مليئة بالتوقعات المنذرة أو المبشِّرة بنهاية الدولة القومية، أو على الأقل بانتفاء أهميتها، في الكتابات الأكاديمية والشعبية على حد سواء. وقد يبدو التركيز النيوليبرالي على الفردية والتجارة الحرة والحكومة المحدودة متنافراً مع القومية، لكن «من خلال إقرارهم تنقل رؤوس الأموال والشركات والأشخاص عبر الحدود، أجبر الليبراليون الجدد الدول على التنافس مع بعضها البعض». وكان الراعيان السياسيان لعصر الليبرالية الجديدة، الرئيس الأميركي رونالد ريغان ورئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر، قوميين متحمسين في خطابهما، وكذلك الحال بالنسبة للرئيس الصيني دنغ شياو بينغ الذي عرّف إصلاحاته الصديقة للسوق بأنها اشتراكية بمواصفات صينية.
وباختصار، يَحكي كتاب سْتُورم القصةَ الطويلة والدراماتيكية لانتشار الأمم عبر العالم وكيف أصبحت الشكلَ المهيمن للتنظيم السياسي في عصرنا، معتبراً أن هذا العصر ما زال بعيداً عن نهايته.
محمد وقيف
الكتاب: القومية.. تاريخ العالم
المؤلف: إيريك ستورم
الناشر: برينستون يونيفرستي برِس
تاريخ النشر: أكتوبر 2024