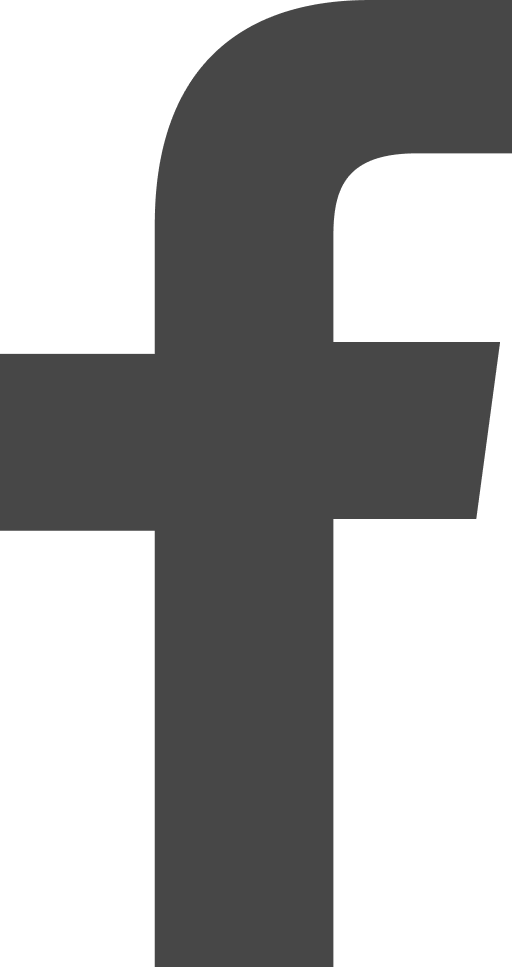تعد القدرة على التمييز بين غث الأمر وسمينه، أحد الفروقات البارزة بين الإنسان وسائر المخلوقات، إذ يستطيع الكائن البشري أن يختار بين البدائل المتاحة، بل إن هذا التمييز هو الحد الفاصل بين الأخذ بتصرفات وأحكام الإنسان على محمل الجد من عدمه، فكيف نأخذ بسلوك طفل دون سن «التمييز»؟
وبالوقوف على أسلوب واتجاه اختيار الإنسان المميِّز لحكم دون غيره، أو القادر على اتخاذ قرار على حساب إهمال آخر، يحيد الإنسان ليدير دفة ذلك المسار بحيث يخدم هدفاً معيناً، أو يشبع حاجةً تميل لها نفسُه، وهنا يقع الصراع بين ثنائية لا تكاد تنفصل بين العقل والهوى، فإما أن يشعر الفردُ بتقدير ومكانة العقل كنعمة يقع فيها لب الإرادة الخيرة والسليمة، وإما أن يتمزق هذا المعنى ويغشى بضبابية الفعل الخارج عن «حلبة التفكير»، والمتسلل وراء رداء العقل، لكنه بالأساس لا ينشد إلا تطبيق الفعل أياً كانت نتائجه.
وإذا ما تساءلنا حول ماهية العقل من وجهة نظر الفلسفة اليونانية، نجد أن أرسطو تعامل مع العقل على أنه جزء من الروح، جزء ذو قدرة معرفية وتحليلية تخلص لإنتاج «فهم» يبتعد عن اعتباره نزعة «طائشة» في اختيارها. وبالرغم من اعتقاده بانفصال العقل عن الجسد، واعتباره كياناً مستقلاً بحد ذاته، فإن ما يقوم به العقل من خطوات لبناء المعرفة، وفقاً لأرسطو، يلغي احتمال كونه قد ينعكس بآثار سلوكية «ناقصة».
ومع ذلك فإن تقدم وتطور العملية الفلسفية، لم يزعزع من التصور المحيط بالعقل، وهالته «المقدسة» في نسبه المتصل مباشرةً مع المعرفة، بل تخطى ذلك في توصيل امتداد العقل مع الوجدان ومكامنه الإيمانية.
وفي النظر للاختلاف الممكن على فهم ماهية وطبيعة العقل لاحقاً في العصر الحديث، نجد أن التركيز لم يتمحور حول الفصل بينهما، ولم يبرز أي اعتبار أو اهتمام لإثبات ذلك، بل التفريق في وظيفة كل منهما، أو طبيعته ومميزاته، إذ يتصف العقل بسكونه وتمحور وظيفته في التفكير، على عكس الجسد الذي يتحرك ولا علاقة له بالعملية التوليدية الفكرية. كما أن العقل خاضع لبعض التطويعات المنطبقة على باقي «مكونات الإنسان» من حيث إلزامية تهذيبه، وأما فيما يتعلق بصورة إنتاجه الأخيرة، فهي متفاوتة لاختلاف «نسبة استثماره»، على الرغم من تساويه لدى كافة البشر من حيث وجود «المادة الخام».
إن استخدام الإنسان لعقله يفسر معنى أن يكون عاقلاً، ويحدد في الوقت ذاته الجدوى من العقلانية، إذ تتمثل نعمة العقل في اتكائها على أساس تكويني سيكولوجي ومعرفي، وتنقلب لدوافع موجهة لـ«نقمة الفعل»، إذا ما تجردت أو انتزع منها «مخ الإرادة والتدبير». وفي حين عرف العقل من «عَقَل الدابةَ» أي ربطها بإحكام خشيةَ هروبها أو شذوذها عن القطيع، لا يبدو من المناسب تطويع وجود العقل لخدمة الهوى بعيداً عن احترام «تقييده المشروع» ضمن نطاق المقبول، وهذا تفسير صورة الرفض المطبوعة في أذهاننا عند التفكير في أمور خارجة عن إمكاناتنا العاطفية أو الحسية أو الأخلاقية أو الدينية.. أو غيرها.
*أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة