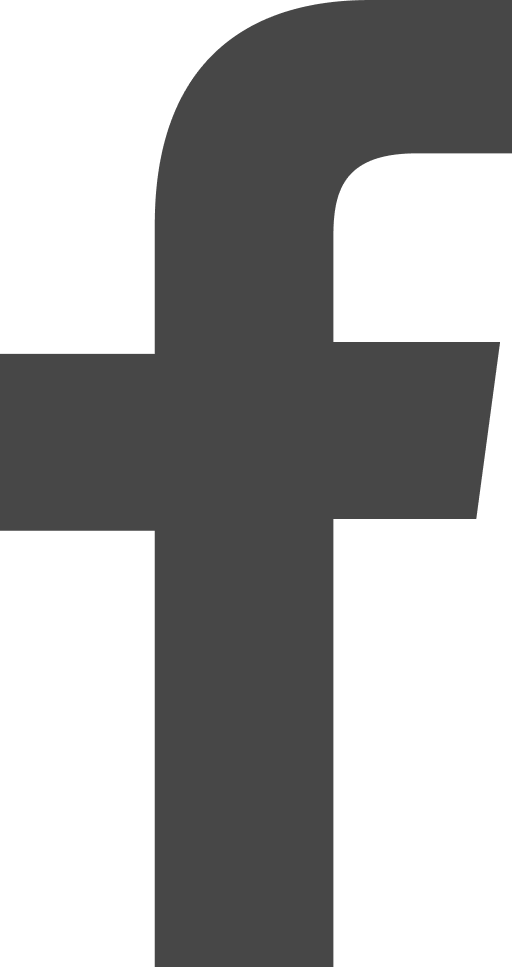منذ خطابه الأول فور تسلمه مقاليدَ السلطة في الولايات المتحدة الأميركية، أظهر الرئيس دونالد ترامب نفورَه العدائي من موجة «اليقظة» (wokism) التي هيمنت على الجامعات وعلى الحركة الحقوقية والنسوية في بلاده خلال السنوات الأخيرة. وليس صراعه الحالي مع المؤسسات الجامعية العريقة، وفي مقدمتها جامعتا كولومبيا وهارفارد، بمنأى عن هذا الخطاب المناوئ لهذه النزعة واسعة الانتشار.
ما تحيل إليه عبارة «اليقظة» هو بصفة عامة الكشف عن مظاهر التمييز والاستغلال البارزة والخفية التي تعانيها المجموعات العرقية والأقليات الثقافية واللغوية، في ما وراء النزعة الكونية للمنظومة الليبرالية القائمة على مبدأ المساواة في الحرية بين أفراد تجمعهم رابطة المواطنة والولاء لدولة قومية جامعة.
ومن الجلي أن هذه النزعة تتغذى من ثلاثة روافد كبرى هي: أولا: الدراسات ما بعد الكولونيالية التي تطورت على نطاق واسع في الجامعات الأميركية خلال العقود الأخيرة، وهي في عمومها ترجع إلى كتاب المفكر الفلسطيني الأميركي ادوارد سعيد «الاستشراق»، الصادر في عام 1978. والفكرة الأساسية التي تنطلق منها هذه الأدبيات، هي وجود علاقة قوية بين استراتيجيات المعرفة والعلوم الإنسانية من جهة ومنظومة السلطة والإقصاء من جهة أخرى، بحيث غالباً ما تشكل الأدوات النظرية مكوناً من مكونات جهاز الضبط والضغط والقمع، بما يستوجب حركة «عصيان ابستمولوجي» تحرر النماذج المعرفية من التحيز والاستغلال. ومن أهم تجليات الخطاب ما بعد الكولونيالي ما عرف بدراسات التابع subaltern studies التي ركزت على تاريخ ووعي المهمشين في مقابل سردية السلطة المعرفية المتحكمة.
ثانياً: الحركة الليبرالية المساواتية في نسختها الأميركية التي حاولت رفع تحدي النقد المجموعاتي لفكرة المساواة الصورية التي يتأسس عليها النظام الاجتماعي المدني. لقد تبنت هذه الحركة، والتي عبّرت عنها بقوة فلسفة جون رولز، معاييرَ الإنصاف بدلاً من العدالة الشكلية، وطرحت خيار العدالة التمييزية والتعويضية لمواجهة الاختلالات والفوارق الطبقية التي تعاني منها الحالة الرأسمالية.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن مصطلح الليبرالية في الولايات المتحدة يحيل إلى الفكر اليساري، على عكس ما هو سائد في أوروبا الغربية. ثالثاً: الفلسفات التفكيكية والنقدية التي اتجهت منذ نهاية الستينيات إلى النقد الجذري لحركة الحداثة والتنوير، في نزعتها الإنسانية الكونية ومنظورها العقلاني التاريخاني، مع الاحتفاء بمفاهيم الاختلاف والمغايرة والهامش.. بما هو جلي في ما يسمى في الولايات المتحدة بالنظرية الفرنسية french theory، والمقصود بها هنا هو حفريات ميشال فوكو وتفكيكية جاك دريدا وجينالوجيا جيل دلوز المستندة إلى أفكار نيتشه. ورغم أن موجة اليقظة كانت مفيدة في بعض الحالات لدفع الحركة الحقوقية المدنية، إلا أنها انتهت في بعض السياقات إلى تكريس وضعية إرهاب فكري حقيقي وصل إلى حد انتهاك معايير الحقيقة العلمية والموضوعية النظرية والتحليلية.
لقد نبه إلى هذه الحقيقة العديد من الباحثين الجامعيين في السنوات الأخيرة، مبينين خطر هذه التوجهات على رصانة وجدية البحث العلمي الذي يجب تجنيبه المؤثرات الأيديولوجية النضالية. والأمر هنا يتعلق من جهة بالأخلاقيات والفضائل الابستمولوجية، ومن جهة أخرى بمعايير النقاش العمومي في المجتمعات الديمقراطية.
وفي الجانب الأول، لا بد من التنبيه إلى الحاجة العميقة إلى إنقاذ فكرة الحقيقة الموضوعية أي انفصال الواقع عن التمثلات والآراء الذاتية، باعتبار أن العلم لا يمكن أن يتشكل وينمو دون مسلّمة الحقيقة الملزمة للعقل والتفكير، مهما كانت شرعية التحفظ على المواقف الوثوقية والأحكام المسبقة والمصادرات الزائفة. فعندما نقول، إن الحقيقة نسبية وتاريخية ونتاج تأويلية لغوية محدودة، ننسف الإطار البرهاني الضروري للممارسة العلمية التي هي خط المواجهة الحاسمة ضد التعصب والجمود والانغلاق. وفي الجانب الثاني، لا بد من الإقرار بأن الديمقراطية تقوم على مبدأ التداول العمومي الحر الذي لا سبيل له من دون أطر ضابطة للنقاش والإجماع في مجتمعات حرة، وهذه الأطر تنبع كلها من فكرة الحقيقة البرهانية المتاحة للجميع والملزمة لهم.
وليس من مجرد الصدفة أن تكون الممارسة الابستمولوجية الموضوعية قد تزامنت من حيث الظهور مع التجربة الديمقراطية وتداخلتا في جوانب ورهانات كثيرة. ولذا، ومهما كان الاعتراض على سياسات الإدارة الأميركية الجديدة في مجال البحث العلمي واستقلالية الجامعات ومؤسسات التفكير والرأي، فمن الضروري الوعي بمخاطر حركة اليقظة التي تقوت في العهود الديمقراطية، باعتبارها خلقت جواً رهيباً من الإرهاب الفكري واستهدفت قيم الموضوعية والتنوير والعقلانية الحداثية التي هي أسس التقليد الديمقراطي الليبرالي.
*أكاديمي موريتاني