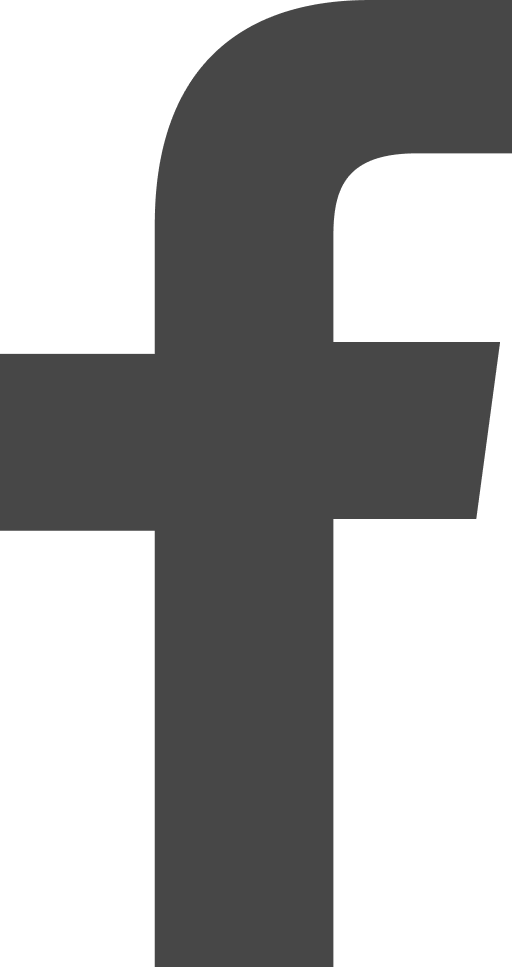لم يكن فرنسيس بابا الفاتيكان مجرد حامل لقب كنسي عريق، بل كان في عمق تجربته الإنسانية نموذجاً فريداً لرجل دين أدرك مبكراً أن العالَمَ، في زمن العولمة الصاخبة والانقسامات الحادة، في أمسّ الحاجة إلى صوت يتجاوز الشعارات، ويد تتقن صناعة الجسور لا بناء الجدران. لقد قدّم قراءةً جديدةً لمفهوم القيادة الدينية، مفادها أن الزعامة الأخلاقية لا تصنعها المكاتب ولا تسكن في القصور، بل تولد من التواضع الفعلي، ومن القدرة على الإصغاء للآخر المختلف، لا من محاكمته أو محاولة ترويضه، بل من فهمه والاعتراف بإنسانيته الكاملة.
وعلى مدى سنواتِ حبريته، أعاد فرنسيس ترتيب سلّم الأولويات في الفضاء الروحي والإنساني، ووضع الحوارَ مع المسلمين في صميم هذه الرؤية، ليس من باب الانفتاح الديبلوماسي التقليدي، بل باعتباره واجباً إيمانياً وقناعةً لاهوتيةً عميقةً. لم يكن يتعامل مع العلاقات الإسلامية المسيحية بوصفها ملفاً سياسياً يمكن تدويره وفق المصالح الآنية، بل رآها التزاماً نابعاً من الإيمان بأن الله لم يخلق الناس ليقتتلوا على الحقيقة، بل ليبحثوا عنها معاً في فضاء من الرحمة والعدل والتعارف.
في وثيقة «الأخوة الإنسانية» التي جمعت قلوب الملايين بتوقيع مشترك مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، تجلت هذه الفلسفة في أبهى صورها، حيث لم يقتصر الخطاب على العبارات الديبلوماسية، بل مضى إلى ترسيخ مبادئ العيش المشترك، وحرمة الدم، وكرامة الإنسان، وضرورة حماية دور العبادة. إنها وثيقة لم تؤسس لعلاقة مجاملة، بل وضعت للعالم خريطةً أخلاقية تتجاوز لحظة التوقيع إلى أفق الرسالة المشتركة.
لكن المحطات الكبرى في هذه المسيرة لم تقتصر على أبوظبي، بل جاءت زيارته إلى المغرب سنة 2019 لتمنح هذا المسار بعداً آخر حين التقى بالملك محمد السادس، أمير المؤمنين، في مشهد استثنائي احتفى بالمسؤولية الدينية كضمانة للعيش المشترك. إعلان الرباط حول القدس، الذي وُلد من هذا اللقاء، لم يكن بياناً عابراً، بل كان موقفاً مبدئياً أعاد القدس إلى مكانتها كرمز جامع للأديان، مدينةً للسلام لا ساحةً للصراع، وأعلن للعالم أن حماية قدس الأديان الثلاثة ليست شأناً إقليمياً ضيقاً، بل قضيةَ ضمير عالمي.
لم يتوقف فرنسيس عند حدود المغرب، بل خطا خطواته الواثقة إلى أرض الرافدين الجريحة، العراق، ليحمل رسالتَه إلى النجف ويلتقي المرجع السيد علي السيستاني، في حدث تاريخي هو الأول من نوعه بين رأس الكنيسة الكاثوليكية ومرجعية شيعية بهذا الثقل. وهناك، بعيداً عن الأضواء المصطنعة، أكّد أن اللقاء الحقيقي بين الأديان لا يكون بالكلمات، بل بالاعتراف المتبادل بالكرامة والحق في الاختلاف.
كانت هذه اللقاءات محطات ضمن رؤية أوسع لم تفصل يوماً بين الإيمان والعدالة الاجتماعية، بين العقيدة والكرامة الإنسانية. في خطابه عن الاقتصاد والسياسة، كما في موقفه من قضايا اللاجئين والبيئة، ظل البابا الراحل ثابتاً على قناعته بأن الأديان ليست معازل للانعزال، بل طاقة لبناء الإنسان في عالم تزداد فيه الحاجة إلى الضمير أكثر من حاجته إلى الأسواق.
لقد كان صريحاً في مواجهة كل أشكال الكراهية، ووقف دون تردد ضد موجات الإسلاموفوبيا، واعتبر أن أي اعتداء على المقدسات، وأي إساءة للمعتقدات، إنما هو خيانة للإيمان قبل أن يكون تعدياً على الآخر. ولم يتوانَ في الإدانة العلنية لكل فعل يمس قدسية القرآن أو يستهدف حرية المسلمين في ممارسة شعائرهم، واضعاً بذلك معياراً جديداً للعلاقات الدينية يقوم على الاحترام المشترك، لا على المجاملة المتبادلة.
ما يلفت في تجربة فرنسيس أنه لم يكن داعياً إلى حوار نظري أو لقاءات شكلية، بل كان يرى في الحوار عملية تراكمية، أي مشروع بناء مستمر للثقة، لا خطاباً استهلاكياً. أدرك أن الكلمة الحقة لا تصدر عن أصحاب القرار فقط، بل تحتاج إلى بيئة ثقافية وروحية تحتضنها وتترجمها إلى برامج ومناهج وسلوكيات.
ولئن واجهت رؤيته معارضةً من تيارات محافظة داخل أسوار الفاتيكان، فقد ظل وفياً لموقفه: إن الحوار لا يهدد الهوية، بل يحميها من السقوط في التكلس والانغلاق، وإن العنف لن ينتصر يوماً على الحكمة، وإن بناء جسور التفاهم يترك أثراً أبقى من الحروب والانتصارات الزائفة.
واليوم، ومع وداع هذا الصوت الذي صار ضميراً عالمياً، تبقى دروسه حاضرة، لا في كتبه وخطاباته وحدها، بل في مسارات أعاد رسمها بعمق: مسارات تعتقد بأن الإيمان الحق هو ذاك الذي يجعل من الإنسان أخاً للإنسان، وأن الأرض لا تتسع للسلام إلا حين تتسع القلوب للرحمة.
لقد غاب الجسد، لكن بقي الخط، وبقي النداء، وبقيت الكلمات شاهدةً على أن هذا الرجل لم يكن مجرد بابا، بل كان معمار الجسور بين الضمائر وأديان السماء.
*أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة