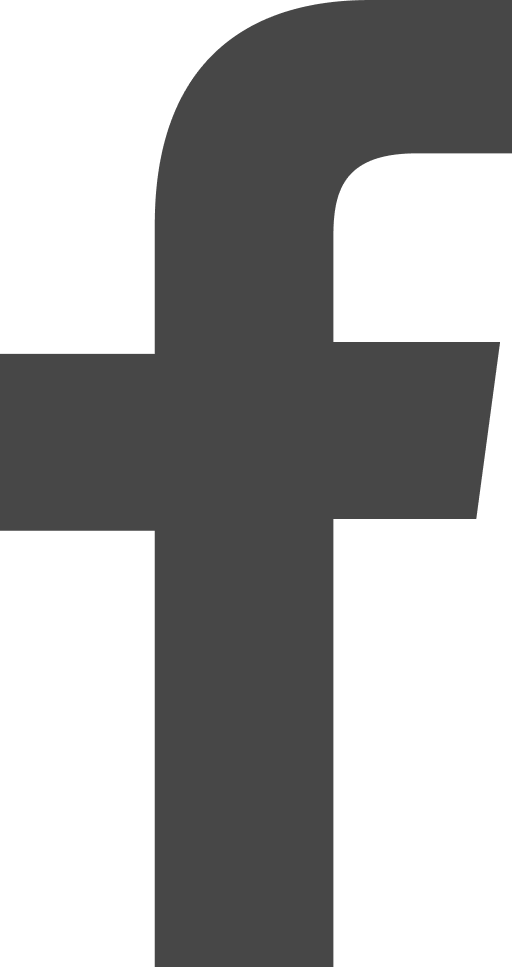كانت جدتي سعيدة بنت مبارك من النساء اللاتي يُعَلمنَ الهدوء كيف يكون ساكناً، سيدة قليلة الحديث قد تبدو شاردة الذهن، لكنها دقيقة الملاحظة والتعليق، تعلمت من جدتي كل ما أحفظه من تراث الأولين، فهي من علمتني الأمثلة التي تعكس التعبير عن الواقع، وأبيات القصيد التي كانت ترفه بها عن النفس أحياناً.
أذكر أنها ذات مرة دار بينها وإحدى صديقاتها حوار انتهى بمثلٍ شعبي «زنجبيل بترابه اللي مايباه يرده على أصحابه»، قالته وكان أشبه بالنطق بالحكم في قضية قتل، إذ ساد صمت مطبق بعدها ثم ترخصت صديقتها وغادرت وهي تتم عبارة: في أمان الله أم مبارك، سلمي على خواتك والبنيات، ظل ذلك المثل عالقاً في ذاكرتي كما يتعلق القلب بمن نحب، فهو مثل فاصل وقاطع. سألت جدتي بعد شهورِ من تلك الواقعة، أمايه، تييكم أمي مينة؟ من يوم العيد العود ماشفتها، كان قصدي من السؤال هو العيدية الراهية اللي كانت تعطيني إياها.
جاء رد جدتي مراوغاً: لا والله من زمان ما لافتنا وعليها الرب حافظ كنت أجس نبضها، عَلّي أستنبط من ردودها تداعيات ذلك المَثَل. بعد صمتٍ وجيز أنشدت تقول: لي مايبونك وش تباهم، يا قلب ما تقبل لي انصاح، عقوك في غية هواهم، ناس يداهونك بالامزاح، وش فيك ما تنقل عزاهم، وتشوم قبل لا تجيك لافضاح. أدركت حينها أن كل أرض شربت ماءها.
وفي بحثي عن الزنجبيل يقول ابن منظور في لسان العرب، الزَّنْجَبِيل: مما ينبت في بلاد العرب بأَرض عُمَان، وهو عروق تسري في الأَرض، ونباته شبيه بنبات الرَّاسَن وليس منه شيء بَرِّيّاً، وليس بشجر، يؤكل رطْباً كما يؤكل البَقْلُ، ويستعمل يابساً، وأَجوده ما يؤتى به من الزِّنْج وبلاد الصِّين، وزعم قوم أَن الخَمْر يسمى زَنْجَبيلاً، قال: وزَنْجَبِيل عاتِق مُطَيَّب وقيل: الزَّنْجَبِيل العود الحِرِّيف الذي يَحْذِي اللسان. وفي التنزيل العزيز في خَمْر الجَنَّة: كان مِزَاجُها زَنْجَبِيلاً.
للعارفين أقول: قضينا طفولة ممتعة، شربنا فيها ماءً غريباً حتى طفرت من تطحيرنا الطحيرة، وعندما مرضنا سقونا الحليب كانوا يفورونه مع الزنجبيل، نشربه فيذوب شمع أذنينا ويتنمل لساننا، ونكون في رحلة شرقي العصر.